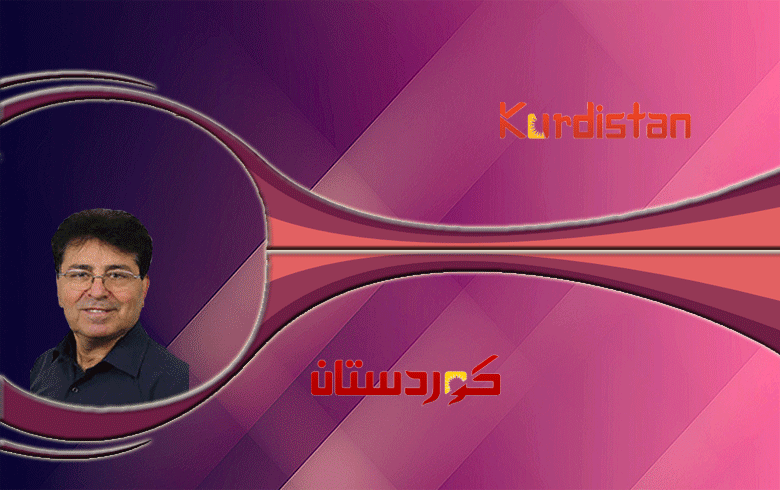قصة قصيرة: الهروب إلى الجحيم
صبري رسول
شدّ انتباهي الرّجلُ الأشعثُ على القناة الإخبارية، انتشلني من البلاهة وهو يتحدّث بنشيجٍ بكائي ردّاً على سؤال المذيعة: انطلقنا في منتصف اللّيل، يقلّنا (البَلَم) الصّغير، بعد نصف ساعة بدأ المركب يتأرجح، وبدأ النّاسُ بالتّساقط، فلم نعد نرى شيئاً وسط عتمة البحر، ففقدْتُ طفلي وزوجتي. وغرق الجميع ونجا منهم ثلاثة أشخاص.
تجمّدت الحياة في عروقي، وانطلقت صيحتي: إنّها ليلاف.
تذكرتُ لقائي الأخير بها صدفةً، يوم عبورِنا بوابة «سي مالكا» هرباً من جحيم حياتنا.
بصوتٍ يشبهُ رنينَ جرسٍ ناشفٍ نادى الموظّف البدين: ليلاف إبراهيم.
أسرعَت المرأةُ ذات الأربعين سنة إلى الرَّجل الواقف كتمثالٍ صامت، يختال بجسمه المحشور في بزّة ضاقَتْ عن شحْمِه المُتراكم. تفحّصَ الرّجلُ ملامحَ المرأة وقارنَها مع البيانات المدوّنة في جواز السّفر -ليتني كنتُ بياناً في جوازها، قيداً، اسماً، رقماً أمام صورتها- ثمّ سألها بلهجة كُردِ زاخو: إلى أين تسافرين؟ فردّت: هولير.
كنتُ جالساً بين حشدٍ كبير من المسافرين المحشورين في مقاعد باردة وقاسية في صالة الانتظار التي تعجُّ باللاجئين الفارين من سوريا والعائدين إليها. مناداةُ الاسمِ هزّتْ أعماقي بقوة، شدّتْني ناحية الصّوت. هفيفُ ظلّها أخذَني إلى حيث خطواتِها، ذات الخطوات التي تركَت على أرصفةِ دراستنا رائحةً رسخَتْ في ذاكرة صداقتنا، ثمّ تعلّقَت نظراتي بقامة المرأة الرَّشيقة وهي تنسلّ بين الحشد المترهّل، حتى وقفَتْ أمام الموظف.
تعرَّفْتُ عليها أيامَ دراسة الدّبلوم في جامعة دمشق، هادئةً كانتْ، ومرحة؛ لاتفارق الابتسامةُ الذَّهبية وجهَها.
شاركْنَا في رحلة طلابية إلى حقلٍ فسيحٍ قرب قدم جبلٍ يتباهَى بعلوّه الشّاهق، يطوّقُ خصْرَهُ نهرٌ يحملُ تاريخَ نقاءِ أهله، يمدُّ حياتهم بعذبِ مائِه. مارسْنا طفولتنا المفقودة في نزهتنا، طفولتُنا سحقَتْها القرية في أزقتها، لعبْنا مسابقاتٍ رياضيةٍ وثقافيةٍ كشفَتْ عن ضحالة معارفنا في اللغة والأدب. شاهدْنَا استعراضاتٍ مسرحيةً تفتقر إلى مقوّمات المسرح، استمعْنا إلى مواويل وأغانٍ جميلة من كلستان سوباري. في استراحة الغداء لم نكن نملك سوى سندويتشات من بقايا غداء أمس، كم كنّا طلاباً تعساء!.
استجمعْتُ شجاعتي المخفية في داخلي لأسمعَها نصوصاً شعرية قد تلفتُ انتباهَهَا، تمهّدُ لي البوحَ بما يختلج في صدري من مشاعر تنامَتْ مع الأيام. لم تكن المرة الأولى التي أحاولُ التقرُّب منها، فذاتُ مرة حاولْتُ استغلالَ وحدتَنا بالمقهى الجامعي اللّعين، وصيدَ انتباهِها إلى مقطوعاتٍ شعرية باهتة، ظنَّاً مني أنّني سأنتزعُ إعجابَها بكلماتي وإلقائي، لكن لم أمتلكْ الجرأةَ الكافية للاعتراف بإعجابي بها، فحاصَرَني خجلٌ طفوليّ قروي، انتصرَ الطبعُ الريفيّ على جرأتي المقموعة، واقتحمَ على وحدتنا زميلٌ يبحثُ عن ثرثرةٍ ضاعتْ منه، وأنقذَني من الموقف الثَّقيل. انتهَت الاستراحة الوحيدة في نزهتنا، ولم أكسّر ترددي، فسيطرَ عليّ الصّمت مرة أخرى.
وجّهَها الموظفُ البدين إلى نافذة التَّأشيرات، وقفَت تتحدّث مع الجالس وراء النافذة البلورية مرةً وتهزّ رأسَها مرة أخرى إيجاباً عن أسئلته الرُّوتينية، ثمّ اتَّجهَت إلى طاولة خلفية في الصّالة، جلسَت مع رجل أشعثٍ اصطبغَ شاربُه بلون دخانه، يجاوره طفلٌ يشبهه كثيراً.
في كلّ لقاء لنا كانت تتحدّث ليلاف عن أبيها وخطّه القومي السّليم، ودوره في العمل السياسي بين أهالي البلدة، كنتُ أتقمّصُ شخصيةَ أبيها في نفسي لتبقى صفاتُه مستمرّة معها، وتسعى لتركِ انطباعٍ عن نفسها لدى الآخرين كسفيرةٍ لقومها في الدّراسة.
أنهيتُ إجراءتي في التَّأشيرة التي أزالت طعمَ فلفل الانتظار الحرّاق من حلقي، ونظراتي لا تحيدُ عنها، تتجمّدُ على تفاصيلها الأنثوية، تتابعُها في كلّ حركة منها، خرجَتْ تتابعُ الرَّجلَ الأشعثَ خارج المبنى، شدّني إليها ظلُّها الأنثوي الفوّاح وأنا أجرّ حقيبتي، اقتربتُ منهم لعلّني أعرف وجهةَ رحلتهم، مازالَتْ تحتفظُ بملامحِها الأنثوية الدَّافئة نفسَها منذُ عشرين سنة، غزَت التَّجاعيدُ جوانبَ فمِها، لكنّ نضارةَ وجهِها مازالَتْ تضجُّ بالجاذبية.
دفعني الفضول إلى الاقتراب منهم، والسّؤال عن وجهتها. سلّمتُ عليهم كمن يجهل الأمر والمكان: مرحباً، كيف الطريق إلى هولير؟
ردّ الأشعثُ بكلامٍ يوحي إلى عدم ارتياحه من السّؤال: أهلاً. هذه السيارات تقلّك إلى هناك، مشيراً إلى سياراتٍ صغيرة تنتظر ركابَها. سألتْني المرأةُ قبل أن أنصرف عنهم: كيف حالك؟ ألم تعرفني؟ ونحن في طريقنا إلى هولير، ننتظر إنهاء إجراءات الآخرين. ابتسمتُ للإيحاء بمعرفتي لها: نعم. أعرفك. هل غادرتم البلاد نهائياً؟
قالت بحسرة: البلاد؟ لم يعد لنا ما يربطنا بها، تركْنَاها لمن يملكها، بعنا المنزل والمحلّ. صمتت برهةً، التفتَتْ نحو الصّالة، ثم إلى وجه الأشعث كعلامة الاستئذان لإكمال حديثها وقالت:
حملْنَا معَنا أوجاعَ وطنٍ تغنّينا باسمه فرَمَانا على قارعة مستنقعٍ، وتدثرنا بوشاح أمنياتٍ لم يشرقْ بريقُها، دفنّاها تحت أنقاضِ طموحِنا المنهار، وانتظرنا فجراً ضبابياً مازال يتألم في مخاضه الأليم.
أفاضَت عن مكنوناتها المختبئة: تخيلْنا أنّنا سنمزّقُ أسمالَ الفقر، وأستار جهلٍ لماضٍ تباهينا به، ركضْنا نحو حلمٍ وقَعَ بين أنيابِ مفترسٍ، كم كان حلمُنَا هشَّاً، وتفكيرُنَا ضحلاً!. لم نكن نعلم أنّنا نصفّق لغيرنا، ونلوّن خرائطَ لم نشاركْ في رسم خطوطها، ونحرسُ بواباتٍ تحمي قصور طغاتنا، ونرتّبُ موائدَ لحفلاتٍ ليست لنا. فنحنُ لسْنا سوى صدى لصوتهم الخارج من أفواهنا، وصوتُنا المكتوم يحتضر في صدورنا قهراً، لسنا سوى حُماةٍ لحرّاسهم. كم تباهينا بتاريخٍ أكثر بؤساً من بؤسنا.
انضمّ إلينا رجلان وامرأة أخرى، يحملون بطاقات العبور إلى المجهول، فسألَه أحدهم: هل أنهيتم أموركم؟ صوتُه المُشبعِ برائحة الدّخان ارتطم بوجهي. فرّدت ليلاف: نعم. ننتظركم.
سألتني ليلاف: هل سترجع إلى سوريا؟ أما زال لك آمال فيها؟
قلتُ بشيء من التّأكيد: منزلي، أولادي، أهلي، مازال قلبي مشدوداً بها، الآن جئتُ زائراً.
قالت بنبرة مشبعة بأسى وألم: بعنا المنزل والمحل، علينا إنقاذ الأولاد بعد إن ابتلعهم الشارع والمصير المجهول. توقّفت لتشهق بعمق، ثمّ أضافت وهي تُمسك بحزام الحقيبة: لم يعد لنا وطنٌ إلا هذه، مشيرة بنظرتها إلى الحقيبة، وضعْنَا الوطنَ فيها، وتركنا ذكرياتنا على الأرصفة هناك.
جرّت ليلاف حقيبتها كما كنتُ أجرّ خيبتي، متوجهة إلى سيارة هناك حيث يقف الأشعث، وبقي الحديثُ معها معلقاً في الهواء، غابتُ السيارة في أفقٍ سديميّ، ثم رحلوا. التصقَ صوتُ الرّجل الآخر ونظرات الأشعث بوجهي. لم أغمض عينيّ حتى غابَ عبقُ ليلاف عن روحي.
بقيت نظراتي معلّقة بشاشة القناة. تهشّمتْ أنفاسي تحتَ وطأة الخبر. الأشعث يُبكي ابنه، مناجياً الناس لانتشال جثّة ليلاف من البحر الذي يبتلع الآلاف دون أنْ يشبع. مازلتُ أشمّ رائحة ليلاف من كلّ نهرٍ ومن كلّ بحر.