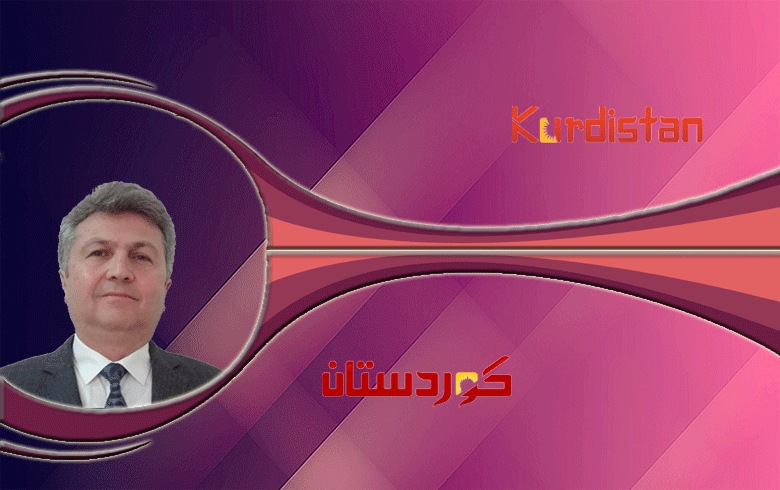ازدواجية المعايير
محمد رجب رشيد
ازدواجية المعايير أو الكيل بمكيالين من أكثر المفاهيم السياسية انتشاراً ومُمارساً في وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، وفي الحياة اليومية للأشخاص، والحياة السياسية للنُخب والأحزاب والحركات السياسية والدول. الازدواجية شكل من أشكال التنافر المعرفي، وتعني الشيء ونقيضه، بمعنى أن تحمل الفكرة ونقيضها في نفس الوقت، أمّا المعايير فهي مقاييس الحكم أو التقييم. وبِناءاً على ما سبق تُشير ازدواجية المعايير إلى عدم الإنصاف في تقييم الأحداث والأمور والأشخاص، أو الموقف منها، أو الحكم عليها، وذلك بمجانبة الحق والتحيُّز إلى الباطل، بحيث يكون مُجحفاً لطرف ولو كان على حق، أو لصالح طرف آخر ولو كان على باطل. وتعود الأسباب إمّا لنوع خاص من المشاعر أو لمواقف مُسبقة أو للحصول على مكاسب شخصية أو لخلفية -عنصرية، دينية، طائفية-. ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أنّ ازدواجية المعايير لا تعني إختلاف الآراء، فالآراء مهما تعدّدت واختلفت تبقى مجرّد آراء ليس لها تَبِعات، بينما ازدواجية المعايير قد تُبنى عليها قرارات تنعكس سلباً أو ايجاباً على الدول والشعوب.
يمكن تفهُّم العمل بازدواجية المعايير أو الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالدول في موقفها من أحداث الساعة والتعامل فيما بينها، كَون الثابت الوحيد في السياسة هو التغيير الدائم حيث تكون المصالح. ولكن كيف يمكن تفهُّم العمل بها من قِبَل وسائل الإعلام والأحزاب والحركات السياسية والنُخب والأشخاص بشكل عام؟ ألا تدلُّ ازدواجية المعايير من قِبَل وسائل الإعلام على فقدانها المصداقية والحياد؟ ومن قِبَل الحركات السياسية والأحزاب -الحاكمة منها أيضاً- على التخلّي عن مبادئهما وشعاراتهما؟ ومن قِبَل النُخب على أنّها لا تستحق هذا اللقب؟ ومن قبل الأشخاص على عدم احترام الذات وعقول الآخرين؟
تكاد تكون ازدواجية المعايير هي القاعدة المعمول بها في السياسة بشكل عام والعلاقات بين الدول، والحِياد هو الاستثناء، فالمصلحة هنا تغلُب المبادئ والغاية تبرر الوسيلة. ونلاحظ ذلك بوضوح في مواقف الدول العربية والإسلامية المؤيّدة والداعمة للقضية الفلسطينية، والمعادية بنفس الوقت أو المتجاهلة على أقل تقدير للقضية الكوردية، رغم الشبه الكبير بين القضيتين من حيث عدالتهما. أمّا الدول العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية فقد اعتادت على الكيل بمكيالين تجاه أغلب قضايا العالم، وخاصة قضية الشعب الكوردي في تقرير مصيره، متجاهلة بذلك أحد أهم مبادئ القانون الدولي من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يقر بحق الشعوب في تقرير مصيرها. بينما وقفت إلى جانب شعب جنوب السودان في تقرير مصيره. ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لقضايا الأمن والسِلم الدوليين وما يتعلّق منهما بمسألتي الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، لقد شكّلت أمريكا تحالفاً دولياً لمحاربة الإرهاب ولكن دون القضاء عليه بشكل نهائي طالما كان بعيداً عنها. بينما أعلنت الحرب على أفغانستان وأسقطت نظام الحكم فيها عندما تلقّت ضربة موجعة من الإرهاب على أراضيها. وفيما يخص السلاح النووي فإن جميع الدول العظمى تدقُّ ناقوس الخطر عندما تحاول دول أخرى -لا تنتمي إلى حلفها- امتلاك السلاح النووي في الوقت الذي تمتلك هي ترسانة منه. ويتجلّى ذلك بوضوح في عدم احتجاجها على إمتلاك إسرائيل السلاح النووي، هذا إن لم تكن قد ساعدتها في تصنيعه، ليس هذا فحسب بل تأكيد الالتزام بأمن إسرائيل منذ عقود من الزمن. وليس أقلّ من ذلك غض الطرف عن تجربة الهند النووية مقابل فرض عقوبات فورية على باكستان عندما قامت بالرد على التجربة الهندية بتجربة نووية مماثلة.
إنّ إزدواجية المعايير لا تقتصر فقط على التعامل بين الدول، بل يلجأ إليها بعض الأنظمة الحاكمة في التعامل مع شعوبها، حيث يُمارس التمييز بشكل ممنهج بين أفراد المجتمع الواحد على أُساس الانتماء القومي أو الديني أو الطائفي. والأسوأ من ذلك هو ازدواجية المعايير في ردة فعل المجتمع الدولي على مثل هذه الانتهاكات التي تتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلَّق بشعوب الشرق الأوسط.
من الملاحَظ أنّ ازدواجية المعايير والتناقضات سياسة أصيلة لبعض الأحزاب والحركات السياسية في العالم المحيط بنا، فعلى سبيل المثال وليس الحصر جميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية مع حركتا حماس والجهاد الإسلامي يطالب بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في انشاء دولته المستقلة. بينما تصريحات أغلب قادتها تكون معادية لتطلعات الشعب الكوردي في تقرير مصيره كشعب أصيل يعيش على أرضه منذ آلاف.
أمّا حركة الإخوان المسلمين التي تعتبر الثورة والعنف من صلب سياستها، ودعمت ما كانت تسمّى بثورات الربيع العربي، إلّا أنّها لم تؤيِّد الحراك الشعبي الإيراني ضد نظام الملالي، بل على العكس وقفت ضده، لِكونِها على علاقة قديمة مع النظام الإيراني تعود إلى ما قبل الاستيلاء على الحكم عام ١٩٧٩م، وتحديداً كانت مع الخميني.
من المعلوم أنّ الانسجام بين الأفكار والأفعال قيمة أخلاقية تُكسِب صاحبها ثقة الناس واحترامهم، بينما التباين في الحكم على أمور متشابهة، والتناقض الحاد بين القول والفعل بمثابة ازدواجية معايير فاضحة، يلجأ إليها بعض الأشخاص لسببين مختلفين لا رابط بينهما، الأول هو مشاعر الحب والكراهية، فمع الحب لا يرى الشخص مساوئ من يحبه، وإن رآها يراها محاسناً، ومع الكُره لا يرى سِوى مساوئه. أمّا الثاني فهو شكل من أشكال النفاق الاجتماعي -إظهار ما لا تُبطِن- فالشخص هنا يُظهِر نفسه للآخرين كصاحب مبدأ، ولكنه في الممارسة مع البعض يتغاضى عنه ويظهر عكسه، إمّا لإرضاء أسياده أو للحصول على مكسب شخصي.
منذ أشهُر توفيّت الكاتبة المصرية المدافعة عن حقوق المرأة نوال السعداوي، وقبل أكثر من سنة كان قد توفّى المفكِّر الإسلامي الدكتور المهندس محمد شحرور الذي اجتهد في تفسير القرآن الكريم، وجاء برؤية معاصرة للإسلام تتناسب مع جميع العصور. ولاحظنا التباين الحاد في الآراء حولهما بحيث لم يعُد مجرد اختلاف في الرأي، بل كان أقرب إلى ازدواجية المعايير على خلفية التطرف الديني في الحكم عليهما من قِبَل الناس، حتّى ذهب البعض إلى تكفيرهما دون وجه حق وخلافاً لحقيقتهما.
يتضح مِمّا سبق أنّ ازدواجية المعايير أو الكيل بمكيالين شكل من أشكال التحيُّز والظلم، وانتهاك لمبدأ العدالة والمساواة والذي يُعرف بالحِياد، وهذا بدوره يقودنا إلى السؤال التالي: ما هو المعيار البديل المقبول؟ هل هو المعيار الأحادي؟ إنّ المعيار الأحادي -القائم على مبدأ من ليس معي هو ضدي- يُعتبر الأسوأ وغالباً ما يكون على خلفية المواقف المسبقة المتجاهلة للحقائق، تلجأ إليه الأشخاص الحاقدة والأنظمة الشمولية وما تدور في فلكها من نُخب وأحزاب وحركات سياسية تنفذ أجنداتها. إذا كان الأمر كذلك فما هو المعيار المنشود؟ لا شكّ أنّ المعيار الحيادي القائم على الموضوعية يبقى هو الأفضل رغم ندرته