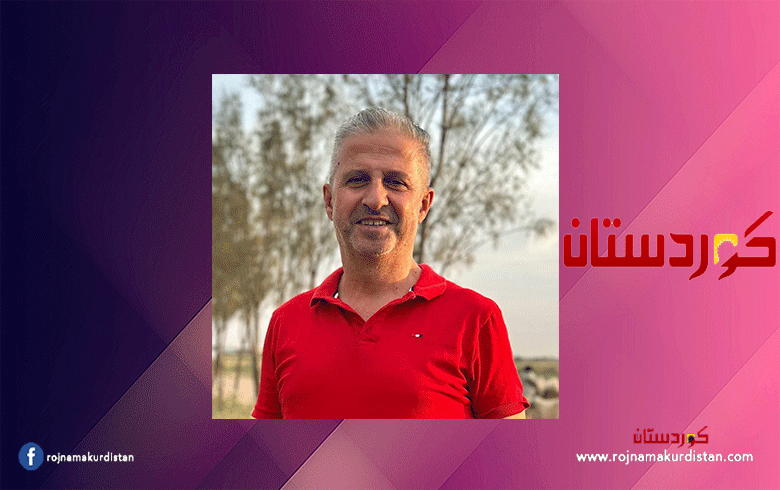ما زلتِ معي.. أو هكذا أظنُّ - قصة قصيرة
كاوا درويش
أمشي بخُطايَ المتثاقلة، قدماي بالكاد تحملاني وأنا أعود من نفس الطريق الذي مضينا فيه وودعتكِ في آخره، أقتربُ من الباب، ألمحه وحيداً مخيفاً، أقف أمامه، أُدخل يدي في جيبي وأُخرج مفتاحي، أتردَّد قليلاً قبل إدخاله، ولكنَّ شيئاً ما يهمس في أذني: افتح الباب، لا بدَّ أنها عادت قبلكَ واستخدمت مفتاحها أو دخلتْ من النافذة، تشجَّعْ، تقدَّمْ وستراها أمامك.
أُدخلُ مفتاحي وأفتحُ الباب برفقٍ خوفاً من إيقاظكِ، أشعر بالهدوء ينساب رائقاً من أسفل الباب مفعماً برائحة الياسمين، رائحتك أنتِ...
أدخل منزلنا وكأنني أدخله للمرة الأولى، أبحث عنكِ في كل غرفةٍ، في كل زاويةٍ فلا ألقاكِ...
ما زلتُ أشمّ رائحتك العالقة هنا، رائحتكِ... رائحتي، رائحتنا التي لاتزال حيةً كأنَّ الوقتَ لمْ يمضِ بيننا... لابدَّ أنكِ هنا، في مكانٍ ما، في ركنٍ ما، حتى أنني أذكر أن زجاجة الماء المثلّجة تلك كانت ممتلئةً، فمن الذي شرب منها؟
حتى وسادتك كانت نائمةً حين غادرتِنا ولم تكن منطويةً على نفسها كما هي الآن، وماذا عن هذه الشعرة الشقراء الطويلة فوق الوسادة؟؟ أليستْ بأقوى القرائن على أنكِ عدتِ يوماً ولو خلسةً؟؟...
أتنقلُ كالمجنون التائه من غرفةٍ لأخرى وكأنّني أسير في متحفٍ لذاكرةٍ مهشّمة.
أذكر أننا ضحكنا معاً في هذه الزاوية، ثم انتقلنا لتلك الزاوية الأخرى فبكينا أيضاً معاً، أما الآن فأنا وحيدٌ أضحك أمام المرآة حتى أبكي ثم أعود فأضحك وهكذا...
يا لسذاجتي وغبائي! كيف فرطتُ بكِ وكيف تركتكِ؟
أكاد أختنق، أفتح الباب لعلِّي أتنفسك قليلاً، تدخلين مع الهواء، تنادينني ليلاً: أغلقْ النوافذ والأبواب ولا تطفئ الأضواء يا مجنون، أنا خائفةٌ حين أكون بعيدةً عنكَ، فأقول لكِ: لا تخافي يا مجنونة، لن أطفئ الأضواء، أنا معكِ حتى وإن كنتُ بعيداً عنكِ...
أصحو في منتصف كل ليلةٍ على هسيسك يتسلل لي همساً: "أشعرُ بالبرد، أحضنّني يا حبيبي"...
لم أبقِ باباً إلا وطرقته سوى باب الأطباء... أطباء القلوب...
لجأت إلى أمهرهم، أكثرهم خبرةً وحكمة، أخبرته عن أعراض الفقد الموجعة، وهلوسات الحنين المزمنة، فإذا به يصمتُ قليلاً، يضطرب هو الآخر اضطراباً لم أفهمه، يدير ظهره لي ويقف أمام نافذته وينظر لبعيدٍ... يدخن سيجارةً، ثم اثنتين، فثلاثة...أتراه هو الأخر يعاني؟ يلتفتُ نحوي وينصحني بالخروج إلى الطبيعة والتحرك أكثر، وبالتحدث والاختلاط مع الناس أكثر، وبالابتعاد عن الحب والعذاب والتعلُّق أكثر وأكثر...
أقف عاجزاً صامتاً أمامه، ماذا سأقول له؟ هل أقول له أنني لا أرغب في الشفاء منكِ أصلاً؟ أم أقول له أنك ماثلةٌ أمامي في كل مكانٍ، في فنجان قهوتي، مع شروق الشمس وتفتّح الزهر، مع هجرة الطيور وهطول المطر، وفي كل أغنيةٍ حزينة...
نعم اعترفت له بكل ذلك، قلت له أنني أراكِ الآن بأمِّ عيني، الآن،
الآن أراكِ تبتسمين معي وتضحكين لي...
ينهرُني، يرفع صوته في وجهي وعينه تدمع: أنت متوهِّمٌ، ما تشعر به ليس حقيقياً، ما تراه أمامك ليس سوى هلوساتٍ وسراباً مخادعاً...
استفقْ، انهضْ وواجهْ مصيرك
فأجاوبه: أعلمُ ذلك، ولكن لا توقظني أرجوك، لا توقظني... أتوسل إليك دعني أحلم...