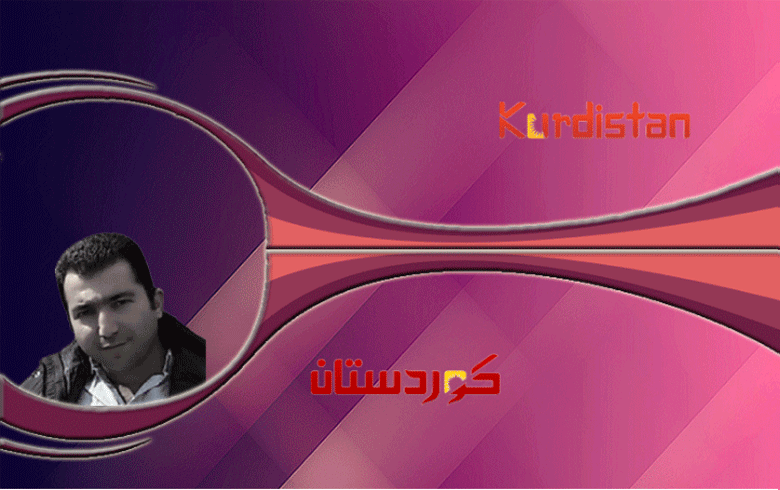الماضي الذي لا يذهب ولا يعود
هنر بهزاد جميدي
أحياناً، ونحن في الغربة، تهبُّ علينا رياح الماضي، تغزو ذاكرتنا بأماكنَ وأشياءٍ بعيدةٍ، منسية في زمانها ومكانها. أمكنةٌ وأحداثٌ دفنتها الأيام في أعماق النسيان، لكنها تستيقظ فجأة لتفرض وجودها علينا، كأنها أزرار القمصان المعلقة بنا.
زخة مطر تهطلُ من جوف السماء، عطرٌ عابرٌ يلامس أبواب الذاكرة، نسمةٌ ريحٍ تحملنا من الحاضر إلى المجهول، حفيف أوراق، أسماء، صور، وجوه، كلمات...
كلُّها تفاصيل بسيطة، تعترضنا وسط زحام الحياة بعفويتها، لكنها رغم بساطتها تهزُّ أعماقَنا، فتثير زلازلَ في دواخلنا، وتعيدُنا إلى أماكن بعيدة، وأزمنة غابرة، وأسماء اختفت في سراب الزمن.
تلك الأشياء الصغيرة والمفاجئة قادرة على إشعال براكين الذكريات في داخلنا، فتحملنا إلى عوالم أخرى وأحقاب بعيدة طوتها الأيام. أصواتٌ وصورٌ غامضةٌ، تغوصُ بنا في أعماق ذاكرتنا، تلك الذاكرة المخدّرة بالزمن والمغلفة بالنسيان.
العجيب في الأمر هو تعطُّش أرواحنا لهذه التفاصيل المبعثرة، وكأنها تبحث عنها دائماً، بلا كلل ولا ملل..
أحياناً، وأنا هنا في السويد، أجدُ نفسي محاصراً بصور عامة وبسيطة من طفولتي: رحلتي مع والدي، وأنا طفل صغير أجلس أمامه على الدراجة الهوائية. قادني إلى أستوديو «الزهراء» لالتقاط صورة وضعتها في ملف تسجيل الصف الأول الابتدائي. ما زلتُ أحتفظ بنسخة منها حتى اليوم. أذكر المصوّر جيداً، كان يشبه جدّي المرحوم الحاج أحمد.
أتذكّر الأحجار التي كنا نجلس عليها خلف حائط مدرسة الطلائع، حين كنا نتسلل من بعض الحصص لنهربَ من رتابة الدروس.
أتساءل أحياناً: ما لون باب بيتنا الأول في قامشلي؟ ذلك البيت الذي انتقلنا إليه من قرية عين ديوار قبل أكثر من أربعين عاماً.
ابنة الجيران، الجميلة، ذات البشرة البيضاء، التي كانت تساعد والدها في بقالة قريبة من منزلنا. أذكر شريطها الأحمر الذي كانت تضعه حول معصمها كإسوارة لا تفارقها أبداً.
حنفيات المياه المعطلة في ابتدائية الوئام بحي «قدوربك»، ورائحة الحمامات وأبوابها المفتوحة.
أصدقاء الحارات الشعبية، وجوه الجيران وصوت بائع الملح ،….
ماذا نفعل أمام هذا الغزو العاطفي؟ ربما نصرخ:
«تباً للحنين! يُعيدنا للأشياء ولا يعيدها إلينا.»
هل نكتب هذه المشاعر على الرمال، لتأتي الأمواج فتغسلها وتأخذها بعيداً؟
أم ننثرها في الهواء لتتلاشى؟ أم نحرقها، لعلّها تنطفئ مع رماد الذكريات؟
الحنين هو الجسر الذي يعيدنا إلى ذواتنا الأولى، تلك التي عاشت وسط تفاصيل صغيرة ومواقف عابرة، لكنها صنعت عالماً مليئاً بالدفء والبراءة.
في رحلة الذكريات، لا نبحثُ عن الزمن نفسه، بل عن أنفسنا التي عاشت فيه. الحنين هو محاولة لإعادة إشعال دفءٍ تسلّلَ من بين شقوق الزمن، كأشعة شمس غابت منذ زمن طويل، لكنها ما زالت تمنح قلوبَنا دفئاً لا ينطفئ.