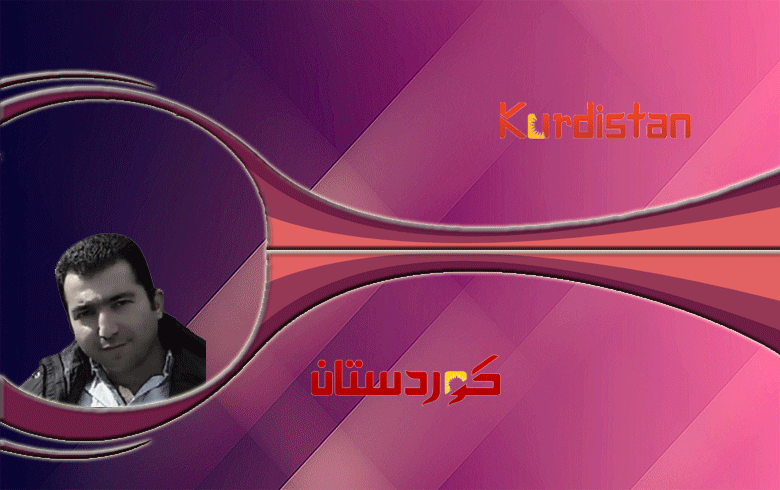في الطريق إلى المكتبة
هنر بهزاد جنيدي
«لقد عوضتني القراءةُ عن الأصدقاء الذين لم يبقوا، والمُدن التي لم أزرْها، وعن الطرقاتِ التي لم أقطَعها، لقد أنرتُ زوايا روحي بالكتب.»
تعود أولى جذور ثقافتي العامة المتواضعة، وبدايات تعلُّقي بالقراءة، وبالكتب إلى مكتبة والدي المنزلية، لم تكن مكتبة الوالد كبيرة من حيث الكم لكنها كانت غنية وقيّمة من حيث التنوُّع والكيف، كانت عبارة عن بهارات ثقافية تحوي كتب الأدب والفكر والفلسفة والسياسة، وعدداً كبيراً من الجرائد والمجلات، وعلى رأسها مجلة «العربي» الكويتية، هذه المجلة التي اعتبرها بمثابة الرحم الثقافي الأول الذي تبنّى تربيتي الأدبية والفكرية، فمن خلال هذه المجلة - كنت في المرحلة الابتدائية-تعرّفتُ إلى كتّاب عظام وأسماء كبيرة تكتب في صفحات وزوايا هذه المجلة بصورة شهرية ومستمرة، يتناولون فيها شؤون وشجون العالم الفكرية والأدبية من شرق العالم إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، كلُّ ذلك في إطارٍ لغويٍّ وأسلوبيٍّ قائم على التبسيط والتشويق والتنوير مع الحضور الدائم للألوان والصور.
معظم المكتبات التي كنت أزورها في تلك المرحلة كانت تعرض كتبها خلف جدران بلورية متينة ومقفلة وكأنها محلات لبيع الذهب والمجوهرات، ويتم تصنيفُها أحياناً في رفوف وراء ظهر صاحب المكتبة “كنت أكره أصحابها” لأنك لم تكن تملك مع مكتباتهم رفاهية لمس الكتاب، وتصفُّح الأوراق والفهارس والعناوين، ولا متعة تذوق الأسلوب، ولا كشف المضمون، هي دقائق قليلة ينتظرك فيها صاحب المكتبة لاتخاذ قرار الشراء أو إعادة الكتاب إلى الرف ثانية.
أستثني هنا بحسب ذاكرتي بعض المكتبات التي كانت تعرض كتبها بطريقة العرض الكريم أولها مكتبة الإيثار في القامشلى “رحم الله صاحبها” ومكتبة أخرى كانت في شارع البشيرية أيضاً في القامشلي، ولا يحضرني اسمها للأسف، وكان مؤسسها مثقفاً من الإخوان المسلمين ومعتقلاً لدى النظام السوري يديرها أولاده في غيابه، كانتِ الكتبُ في هذه المكتبات معروضةً في الرفوف المكشوفة والمفتوحة وموضوعة على طاولات في الوسط وصاحب المكتبة جالس في زاوية بعيدة عنك، ولك الحق في حمل كلّ الكتب المعروضة وفتحها وتصفُّحها وتشريحها، كلمة كلمة، جملة جملة، صفحة صفحة قبل المغامرة بالشراء، وأضيف إلى هذه القائمة حديثاً اسم مكتبة مانيسا في ديريك.
الكتب كانت غالية الثمن، وكان يصعب إلا على المقتدر مادياً متابعة وشراء الجديد والقيِّم من إصداراتها الشهرية أو السنوية، وربما كنتُ محظوظاً بعض الشيء في هذا الخصوص لأن أبي كان ومازال قارئاً متابعاً ومحباً للمطالعة، وحريصاً على جمع المقدور عليه من الكتب والمجلات في المكتبة المنزلية، فورّطني -أنا ابنه- هذه الورطة الجميلة، ودون أن يعلم بورطتي هذه إلا في الآونة الأخيرة وأورثني حبّه للكتب والقراءة، وكتابة الاقتباسات وحفظ الحكم والأقوال.
لا يذهب ظن القارئ بعيداً أثناء قراءة هذه المقالة، فلست دودةَ كتب كما قد يتصوّره البعض، فأنا في ظروفي الحالية قارئٌ بطيءٌ وكسول و مقل جداً فيما أقرأ، أو أكتب، ذاك بحكم متطلبات وانشغالات الحياة الأخرى من أسرة وأطفال وعمل، وزادت عليها هموم الهجرة والاغتراب فكلُّها مجتمعة تسرق الأوقات الطويلة، وتهدر الطاقات العالية، ولا تبقي للقراءة والكتابة سوى لحظات قليلة مسروقة بِحِرفيّةٍ عالية من ضجيج هذا العالم الصاخب.
إلا أنّ الكتابَ كان، وسيبقى نديمَنا الأول، وأنيسنا الأول الذي نحمله معنا حيث نذهب، ونسافر، ونعمل، ونقيّم، وهو دائماً بقربنا لمدّنا بالطاقة والحب والإرادة في ساعات الضجر والملل، وفي لحظات الضعف والحزن، نستعين به طبيباً مخلصاً ومرشداً حكيماً لم يخب ظننا به يوماً.
«فإن كلّ إنسان يجبُ أن يكون طالباً طول حياته، وأن يموت كما مات الجاحظ (وعلى صدره كتاب)».