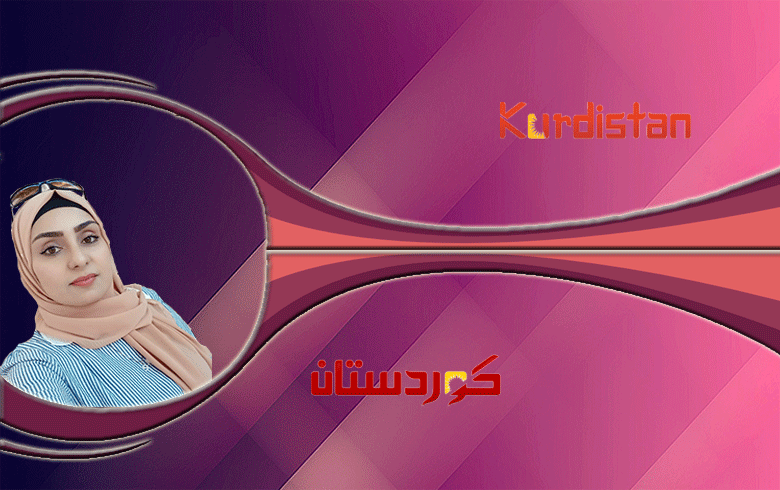شرعية الدستور... بين القانون والقبول الشعبي
شيرا حاجي
من المفترض أننا نعيش في دولة القانون، دولةٌ يحدد فيها مصير الشعب وإدارة مؤسساته.. كلماتٌ ضمن قرطاسةٍ صغيرة لا يراها إلا ذو حظٍ عظيم.
هذا ما يُدعى بالدستور، في حين يتجاهل الكثيرون حول الدستور والمقصود به، ودوره في حياتهم وفي إدارة المجتمع بشكل عام، وتسيير وتحديد مصير شعبٍ يعيش في هامش دولةٍ كل همهم الحلم والتفكير في غدٍ أجمل، دون الالتفات والبحث عن حقيقة مالهم من حقوق، وهل هذه هي الحياة المقدرة لهم أم المفروضة عليهم في هذا الشيء الذي يدعى بالدستور؟
في حين لا يعرفون إذا كان الدستور رجلاً فرض رأيه وسلطته وقوته عليهم، أو هي ألواحٌ ألقي عليهم من السماء فيه عدلٌ وإحسانٌ ورحمة.
لا فائدة من دستور لا يقرّر فيه الشعبُ مصيرَه، ولا يحمل في طيّاته العدل والمساواة حتى لو جاء ألف قائد وتغير ألف حكم.
دستورنا الجديد في سوريا يا ترى: هل سيكون خليفةً لدستور لم يترك وراءه سوى الفساد والدمار؟ أم سيكون دستوراً فيه يغاثُ الناس، وفيه يُعصرون؟
في كل دولة، يُنظر إلى الدستور على أنه القاعدة العليا التي تُبنى عليها مؤسسات الحكم، والقوانين، والعلاقة بين الحاكم والمحكوم. لكن وسط هذه الهالة الدستورية، تبرز تساؤلات جوهرية: هل يكفي أن يكون الدستور "قانونيًا" حتى يكون "شرعيًا"؟ وهل يمكن لدستور أن يُسنّ وفق الإجراءات، لكنه يُفرض على الناس دون رضاهم.
إن الفرق بين شرعية الدستور وقانونيته يشبه الفرق بين الشكل والمضمون. فالقانونية تعني أن الدستور صدر بطريقة معترف بها من الناحية الإجرائية، أي أنه اتبع المسار الصحيح، سواء عبر لجنة صياغة أو مجلس تأسيسي أو استفتاء. أما الشرعية، فهي الأهم والأعمق؛ وهي تعني أن هذا الدستور مقبول من الشعب، يمثل إرادته، ويعكس تطلعاته.
بعبارة أخرى، يمكن لدستور أن يُعتبر قانونيًا، لكنه يفتقد إلى الشرعية إن جاء نتيجة انقلاب، أو في غياب تام للمشاركة الشعبية، أو في ظل قمع سياسي يمنع النقاش والحوار.
تجربة الشعوب.. الدستور ليس نصًا منزّلاً
في تجارب كثيرة، رأينا دساتير مكتوبة بدقة، مدعومة بنصوص متقدمة، لكنها لم تصمد أمام واقع الرفض الشعبي. فالدستور ليس مجرد وثيقة مكتوبة، بل عقد اجتماعي، يحتاج إلى موافقة شعبية حقيقية حتى يُكتب له البقاء. والدساتير التي تُفرض من الأعلى، مهما بدت قانونية، لا تُعمّر طويلًا.
في المقابل، نجد أن بعض الدساتير التي خرجت من رحم الشعوب، وعبر حوارات وطنية واسعة، استطاعت أن تُحدث استقرارًا سياسيًا، حتى وإن لم تكن مثالية في نصوصها. فالمعيار هنا لم يكن الكمال القانوني، بل القبول الشعبي والشرعية السياسية.
القانون لا يُغني عن الشرعية
في الدول التي تمر بتحولات سياسية أو مراحل انتقالية، يخطئ من يظن أن وضع دستور جديد كافٍ لتأسيس نظام ديمقراطي. فالدساتير التي لا تُكتب بالتوافق، ولا تُعرض على الشعب في استفتاء حر ونزيه، تبقى حبراً على ورق. وهذا ما أكدته تجارب الربيع العربي، حيث سقطت أنظمة، وجاءت دساتير جديدة، لكن بعضها فشل لأنه افتقر للشرعية.
السؤال الذي يجب أن يُطرح عند وضع أي دستور هو: هل هذا النص يُعبّر فعلاً عن إرادة الناس؟ هل شاركت فيه القوى السياسية والاجتماعية؟ هل يحمي الحقوق؟ هل يضع السلطة تحت المساءلة؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة هي ما يصنع الفرق بين دستور يعيش وآخر يُطوى سريعًا.
الخلاصة من كلّ ما سبق يتّضح لنا أن دستورنا الحالي يفتقر إلى كل هذا.
لا شك أن الدول التي تحدث فيها انقلابات، وتبدأ المرحلة الانتقالية، تعم الفوضى، وتوضع قوانين مؤقتة أساسية إلى حين استتباب الأمن في البلاد، ومن ثم وضع قوانين وأنظمة دائمة ومن المفروض ان تكون عادلة.
الشرعية ليست تفصيلًا قانونيًا، بل هي أساس النظام السياسي. والقانونية ليست غطاءً كافيًا لتمرير دستور غير عادل أو مفروض. بين الاثنين، تُبنى الدول أو تنهار. وفي النهاية، لا يُكتب البقاء إلا لدستور يخرج من الناس، وللناس، ويعود إليهم.