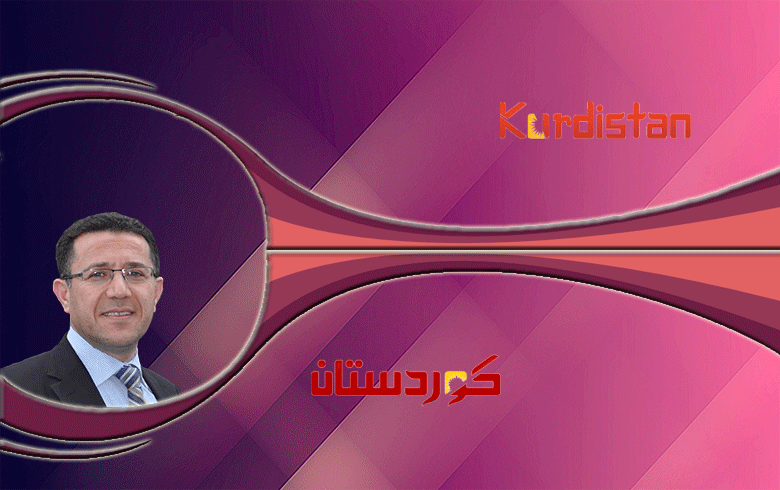سوريا… الخطر الذي يتغذّى من الداخل قبل الخارج
د. كاميران حاج عبدو
الأزمة السورية التي تفجّرت عام ٢٠١١ لا يمكن اختزالها في صراع النفوذ الإقليمي أو التدخُّلات الدولية فحسب؛ بل تعود في جوهرها إلى إشكالية الانتماء الوطني الذي لم يتبلور منذ الاستقلال. فمنذ نشوء الكيان السوري بعد الحرب العالمية الأولى، وفق خرائط استعمارية لم تُراعِ مصالح شعوب المنطقة وتطلعاتها، أخفقت السلطات المتعاقبة في صياغة هوية وطنية جامعة تستوعب مختلف المكوّنات السورية، فيما ظلّت الولاءات القومية والدينية والمذهبية والعشائرية أكثر رسوخاً وتأثيراً، الأمر الذي حال دون قيام دولة مستقرة قادرة على مواجهة التحديات، وجعل البلاد عرضة للانقسامات الداخلية والتجاذبات الخارجية في آن معاً.
على امتداد ستة عقود من حكم البعث، لم يسعَ النظام إلى صياغة مشروع وطني جامع قادر على استيعاب التنوّع الاجتماعي والسياسي في البلاد. فقد انصبّ اهتمامه على تكريس الأيديولوجيا القومية-الاشتراكية بوصفها أداة شرعنة، وعلى إدامة هيمنته عبر منظومة قمعية ممنهجة. هذا المسار أدّى إلى إضعاف بنية الدولة، وجعلها عرضة للتفكك في مواجهة أي حراك شعبي واسع أو تدخل خارجي فاعل.
مع اندلاع الأزمة، تحوّل الصراع السوري إلى نموذج معقد من صراعات العصر الحديث، حيث تتداخل العوامل الداخلية مع التدخلات الخارجية في مشهد يجعل أي قراءة سطحية للأزمة غير كافية. لم تكن الحرب نتيجة لمؤامرة خارجية فقط، بل جاءت نتيجة مباشرة لبنية سياسية واجتماعية ضعيفة، افتقرت إلى عقد اجتماعي يعكس التنوع السوري ويحتضن مختلف مكوّناته.
في هذا السياق، أصبح التدخل الإقليمي، ولا سيما التركي، أكثر وضوحاً مع مرور الوقت. فالعمليات العسكرية لم تعد مجرّد إجراءات دفاعية لحماية الأمن القومي كما يزعم النظام التركي، بل تحوّلت إلى مشروع توسُّعي مرتبط بما يُعرف بـ«العثمانية الجديدة». عمليات مثل «درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع السلام» تجاوزت السيطرة العسكرية لتشمل النفوذ السياسي والاقتصادي والإداري في مساحات واسعة من شمال سوريا.
وهكذا لم يقتصر أثرها على إضعاف سيادة الدولة فحسب، بل عمّق شعور السكان المحليين بأنهم جزءٌ من دوائر النفوذ الإقليمي، مما يقوّض أي محاولة لبناء سلطة وطنية مستقرة.
وبينما كانت التدخلات الخارجية تُرسّخ نفوذها، شهد الداخل السوري فراغاً سياسياً ومؤسساتياً كبيراً، ما فتح المجال أمام صعود قوى الإسلام السياسي والجماعات السلفية الجهادية. تلك القوى استغلّت شعارات الحرية والكرامةً في البداية، وتستّرت بها لتفرض سلطتها على الواقع بالقوة، معيدة إنتاج الإقصاء الاجتماعي تحت غطاء ديني، ومكثّفة الانقسامات القومية والدينية، بما زاد من تفتت المجتمع وصعوبة صياغة عقد اجتماعي جديد للتعايش.
أحد أبرز انعكاسات هذا الفشل البنيوي هو أزمة الاعتراف بالآخر. فغياب مشروع وطني شامل جعل التعايش بين العرب والكُرد، السنة والعلويين، المسلمين والمسيحيين والأيزيديين هشّاً ومؤقتاً، بدلاً من أسس متينة. كما أن غياب الديمقراطية والثقافة الحقوقية جعل شريحة واسعة من السوريين تتقبل القمع والتمييز كأمر طبيعي. وقد تجلّت هذه الأزمة بأوضح صورها، على سبيل المثال لا الحصر، خلال كارثة الزلزال عام ٢٠٢٣، حين جرت عمليات الإغاثة وتوزيع المساعدات وفق الولاءات السياسية والقومية والفصائلية، لا وفق الحاجة الإنسانية. أظهر ذلك ضعف الترابط الاجتماعي وانعدام الشعور بالانتماء إلى وطن قادر على ضمان العدالة والمساواة، ما أضفى على الكارثة بعداً إنسانياً واجتماعياً مؤلماً.
إذا أردنا إنقاذ سوريا، فلا بدّ من معالجة جذور الأزمة التي فتحت الباب أمام حرب أهلية مدمّرة وتدخلات خارجية متشابكة، لا يزال الشعب السوري يدفع ثمنها حتى اليوم.
التحدّي الأكبر أمام سوريا اليوم ليس التدخل الخارجي وحده، بل غياب عقد اجتماعي جامع يعكس التنوُّع السوري، ويحتضن جميع مواطنيه. هذا الغياب يجعل أية تسوية سياسية مستقبلية مجرّد هدنة مؤقتة قابلة للانهيار.
مع ذلك، يبقى الأمل قائماً في إمكانية تغيير المسار. الحل يكمن في قبول الآخر والعمل معاً على بناء وطن يقوم على الحرية والعدالة والمساواة، وطن يعيد الُّلحمة لشعبه، ويمنح أبناؤه شعور الانتماء والمواطنة. سوريا المستقبل لا يمكن أن تقوم على اتحاد قسري أثبت فشله في أكثر من زمان ومكان، كما حدث في الاتحاد السوفييتي (السابق) ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا، بل يجب أن يكون اتحاداً اختيارياً حراً يرتكزُ إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، حيث يصبح الاختلاف مصدر قوة لا سبباً للتفكك. إن العمل المشترك من أجل الصالح العام هو مفتاح إعادة إنتاج دولة تحمي مواطنيها وتعيد سوريا إلى مسار الاستقرار والازدهار.
اليوم، سوريا أمام مفترق طرق: إمّا الاستمرار في دوامة العنف والانقسام، أو المضي قدماً في مسار صعب لكنه ممكن، يقوم على بناء مؤسسات مدنية، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وصياغة مشروع وطني شامل. حينها، لن يكون ما يُعاد بناؤه مجرد أرض تحت سلطة ما، بل وطنٌ يسكن قلوب أبنائه، ويمنحهم حياة كريمة ومستقبلاً مستقراً.