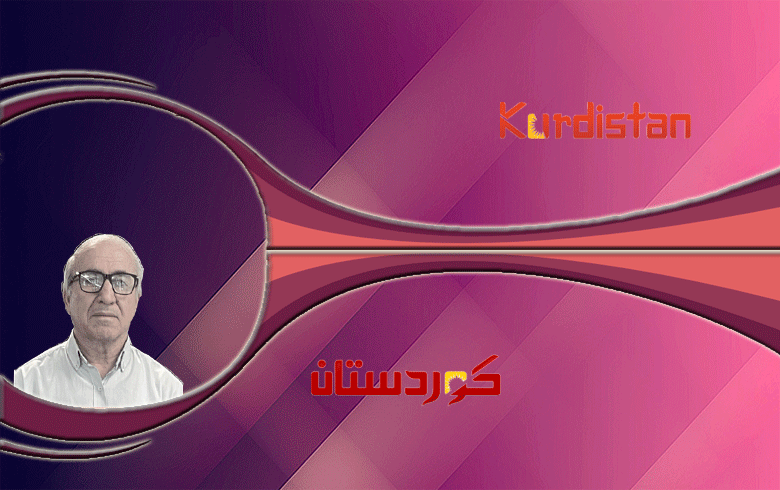ما بعد الميليشيات: الطريق إلى استعادة الدولة
محمد أمين أوسي
تواجه كلٌّ من سوريا والعراق ولبنان تحدّياتٍ كبرى ترتبط بانتشار الميليشيات التي تعمل خارج سلطة الدولة أو بالتوازي مع مؤسساتها الأمنية، وقد تفاقمت هذه الظاهرة بشكلٍ لافتٍ خلال العقود الأخيرة في ظلّ الصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية والتوترات الطائفية والمذهبية. وعلى الرغم من أن هذه الميليشيات نشأت في سياقات مختلفة، فإنّها تلتقي في نقطةٍ مشتركةٍ تتمثّل في تقويضها لسيادة الدولة المركزية وتهديدها للوحدة الوطنية، فضلًا عن عرقلة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في البلدان الثلاثة. ومع تصاعد مطالب الإصلاح والاستقرار، بات جليًّا أنّ القضاء على دور هذه الجماعات أو احتواؤه وإعادة الاعتبار للمؤسسات الرسمية هو المسار الوحيد للخروج من دوّامة العنف وبناء مستقبلٍ آمنٍ ومستقرٍّ للجميع.
ينبغي فهم الأسباب التي دفعت إلى بروز هذه الميليشيات قبل التطرّق إلى دورها الحالي وسبل إنهائه. فقد عانت منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما سوريا والعراق ولبنان، من تدهورٍ كبيرٍ في الأوضاع السياسية والأمنية منذ أواخر القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين. في العراق مثلًا، وبعد سقوط النظام السابق عام 2003، برزت جماعات مسلّحة مختلفة، وقد ساهمت حالة الانهيار المؤسساتي والسيولة الأمنية التي سادت تلك الفترة في توفير بيئةٍ خصبةٍ لنموّ هذه الجماعات، إلى جانب تدخلاتٍ إقليميةٍ ودوليةٍ وجدت ضالتها في استقطاب حلفاء محليين يحققون لها النفوذ، ويدافعون عن مصالحها. في لبنان، يُعَدّ تاريخ الحرب الأهلية (1975-1990) صانعًا لمشهدٍ تتقاسمه الطوائف والمذاهب، حيث أسهمت سنوات القتال الطويلة في بروز فصائل مسلّحةٍ متعدّدة الهوية والمنهج، ولم تُفلح اتفاقية الطائف في إنهاء جميع هذه التشكيلات، إذ بقي بعضها حاضرًا بقوّةٍ في المشهد السياسي والأمني. أما في سوريا، فقد تفجّرت الأوضاع منذ عام 2011، ودخلت البلاد في حربٍ مدمّرةٍ أدّت إلى انقسام المجتمع وتهالك بنية الدولة، ما سمح لكثيرٍ من المجموعات المسلّحة بأن تفرض نفسها لاعبًا أساسيًا على الأرض.
إنّ القاسم المشترك في هذه السياقات هو ضعف سلطة الدولة وتردّي قدرتها على توفير الأمن والخدمات والتماسك الاجتماعي، بالإضافة إلى تراكم الفساد والمحسوبيات في مؤسسات الحكم، ما شجّع بعض المواطنين على اللجوء إلى خياراتٍ بديلةٍ تتبنّاها الميليشيات. ومع أنّ هذه الجماعات قدّمت نفسها في مراحل معيّنة بوصفها حاميةً لطائفةٍ أو عرقٍ ما، أو كمدافعةٍ عن أرضٍ أو مذهبٍ معيّن، فإنّ دورها الحقيقي غالبًا ما تجاوز ذلك؛ فقد تحوّلت الميليشيات في أحيانٍ كثيرةٍ إلى أذرعٍ لأجنداتٍ خارجيةٍ تتلقّى التمويل والسلاح، وتسعى إلى الحفاظ على مصالح الدول الراعية لها.
إنّ استمرار دور الميليشيات يعزّز التشرذم والفرقة داخل المجتمعات في سوريا والعراق ولبنان، ويحول دون بناء هويةٍ وطنيةٍ جامعةٍ تتجاوز الانتماءات الفرعية. فالولاء لهذه المجموعات يسبق الولاء للدولة ويضعف الشعور بالمواطنة، وليس من المبالغة القول إنّ الميليشيات تخلق “دولًا موازية” تفرض قوانينها الذاتية على مناطق نفوذها، مما يعمّق الانقسامات ويغذّي ثقافة العنف كأداةٍ لحسم الخلافات. ويدفع المجتمع الثمن الباهظ لهذه الصراعات، سواء من حيث الخسائر البشرية أم الانهيار الاقتصادي والتنموي. فوجود هذه الجماعات يعرقل أي محاولةٍ لجذب الاستثمارات وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار، لأنّ رأس المال ينفر من مناطق النزاعات والفوضى الأمنية.
ليس من السهل إنهاء دور الميليشيات أو احتواؤه، خصوصًا في ظلّ الاشتباك الإقليمي والدولي الذي تستغله هذه الجماعات.
على المستوى الداخلي، يدرك كثيرون في هذه البلدان أنّ الدولة قد تكون عاجزةً عن تأمين الحماية أو توفير فرصٍ عادلةٍ في ظلّ استمرار الفساد وضعف أجهزة إنفاذ القانون. لذلك يلجأ الأفراد أحيانًا إلى الاحتماء بتكتّلٍ طائفيٍّ أو عشائريٍّ أو مناطقيٍّ يرونه أكثر قدرةً على تأمين مصالحهم وحمايتهم، خاصةً إذا كانت الذاكرة الجمعية مشبعةً بالخوف من اعتداءاتٍ أو صراعاتٍ سابقة. من هنا، يتضح أنّ تفكيك الميليشيات لا يمكن أن يكون إجراءً عسكريًا أو أمنيًا بحتًا، بل لا بدّ من عمليةٍ سياسيةٍ شاملةٍ تعالج جذور الانقسامات وتعيد بناء جسور الثقة بين المكوّنات المختلفة.
ينطلق الأمل في إنهاء دور الميليشيات من إدراكٍ متزايدٍ لدى الشعوب والقوى الوطنية بأنّ هذه الجماعات تعيق تحقيق الاستقرار والازدهار. يمكن استثمار هذا الوعي في إطلاق حواراتٍ وطنيةٍ شاملةٍ تعيد تعريف العقد الاجتماعي وتبحث في آلياتٍ تضمن تمثيلًا سياسيًا عادلًا لجميع المكونات. وقد يستلزم ذلك إصلاح الدستور أو القوانين الانتخابية، كي يشعر الجميع أنّهم جزءٌ من عملية صنع القرار ولا يحتاجون إلى تكوين مجموعاتٍ مسلحةٍ لفرض إرادتهم. كما أنّ توفير بدائل اقتصاديةٍ للشباب والشرائح التي قد تنخرط في هذه الميليشيات يُعَدّ شرطًا أساسيًا لحرمانها من البيئة الحاضنة. ويحتاج الأمر أيضًا إلى تبنّي برامجٍ لإعادة تأهيل المقاتلين ودمجهم في الحياة المدنية، وصياغة مشروعٍ وطنيٍّ يشمل التنمية البشرية والإعمار وتعزيز التعليم، حتى لا تتجدّد دورة العنف كلّ بضع سنوات.
من العوامل الأساسية لإنجاح عملية إنهاء الميليشيات هو إصلاح المؤسسة الأمنية والعسكرية، وجعلها أكثر احترافًا ووطنيةً، وهذا المسار ليس سهلًا؛ لأنه يستدعي تفكيك الولاءات القديمة وتأسيس ثقافةٍ مؤسّساتيةٍ جديدةٍ قائمةٍ على معايير مهنية، وإخضاع قوات الأمن والجيش للرقابة القضائية والبرلمانية لضمان عدم تورطها في انتهاكاتٍ أو فساد. بهذا الشكل، تستعيد الدولة هيبتها وينحسر دور الميليشيات تدريجيًا، لأنه لا يمكن لها أن تصمد في ظلّ وجود مؤسساتٍ قويةٍ وقضاءٍ مستقلٍّ ورقابةٍ شعبيةٍ فاعلة.
ثمة دورٌ مهمٌّ للمجتمع الدولي والإقليمي في تسهيل أو عرقلة هذا المسار. فمن ناحيةٍ أولى، لا بدّ من وضع حدٍّ للتدخلات الخارجية التي تستغلّ الميليشيات كأدواتٍ لمدّ النفوذ؛ إذ إنّ بقاء هذه الجماعات مرتبطٌ بتدفّق السلاح والمال إليها. كما يمكن للمنظمات الإقليمية أن ترعى حواراتٍ بين مختلف الأطراف الداخلية بهدف بلورة تسويةٍ تاريخيةٍ توقف النزيف وتحمي سيادة الدولة. لكنّ مفتاح هذا النجاح يبقى في الداخل، عبر بناء رأيٍ عامٍّ يرفض استمرار دور الميليشيات ويمارس الضغط على القوى السياسية لتبنّي حلولٍ جذرية.
يبدو أنّ الوقت قد حان لإدراك العواقب الوخيمة المترتبة على وجود الكيانات المسلّحة غير الخاضعة لسلطة الدولة. فقد أنهكت الحروب والنزاعات المجتمعات في سوريا والعراق ولبنان، وألحقت بها أضرارًا كبيرة يصعب ترميمها من دون مشروعٍ شاملٍ للنهوض الوطني. وما يشهده الشارع من احتجاجاتٍ متكرّرةٍ على تردّي الأوضاع المعيشية هو مؤشرٌ على حجم النقمة الشعبية تجاه أي سلطةٍ، حكوميةً كانت أم ميليشياوية.
إن إنهاء دور الميليشيات يُعدّ جزءًا أساسيًا من الطريق نحو تصحيح البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإطلاق عجلة التنمية. ومع أنّ التحديات التي تواجه هذا المسار شديدة التعقيد، فإنّ المسار البديل المتمثل ببقاء سلطات الأمر الواقع سيؤدّي إلى مزيدٍ من التصدّع في المجتمعات وتحويل الدول إلى كياناتٍ هشةٍ لا تقوى على النهوض.
ليس من المبالغة القول إنّ تفكيك الميليشيات وإعادة بناء الدولة هما بمثابة عمليةٍ جراحيةٍ دقيقةٍ تتطلب تضحياتٍ وتنازلاتٍ من الجميع، كي تُمحى ذاكرة الحرب والظلم والخوف. وفي الوقت نفسه، لا يمكن تجاهل أنّ نجاح مثل هذا التحوّل سيترك أثرًا إيجابيًا كبيرًا في مستقبل المنطقة كلّها، وليس فقط في تلك البلدان. إذ إنّ استعادة سلطة الدولة المركزية في سوريا والعراق ولبنان ستعزّز مناعة النسيج الاجتماعي وتحفّز الاستثمارات وتخلق بيئةً مواتيةً لتطوّر الديمقراطية. وعلى المدى البعيد، قد يؤدّي تراجع نفوذ الميليشيات إلى تخفيف حدّة التجاذبات الإقليمية، إن تزامن ذلك مع رغبةٍ دوليةٍ حقيقيةٍ في تهدئة الصراعات وإعادة ترتيب الأوضاع.
الطريق نحو هذه الغاية طويلٌ وشاقٌّ، لكنّ الواقع يفرض ضرورة البدء بخطواتٍ ملموسةٍ في مجالاتٍ رئيسية، كالإصلاح الأمني والعسكري، وإرساء العدالة الانتقالية، ومكافحة الفساد، وتنشيط الاقتصاد، وفتح حوارٍ وطنيٍّ جامعٍ يمنح الجميع فرصةً للمشاركة في بناء مؤسساتٍ حديثة. إنّ أولى بوادر نجاح هذا المشروع تكمن في تحوّل الوعي الشعبي نحو إدانة منطق السلاح والتدخلات الأجنبية، والإصرار على قيام دولةٍ مدنيةٍ تُحترم فيها الحقوق والحريات. وما دام المواطن يعاني الأمرّين في أمنه ومعيشته، فإنّ تجاوبه مع أي خطّةٍ للخلاص من سطوة الميليشيات والفساد سيكون تلقائيًا، شريطة أن تُقدَّم حلولٌ واقعيةٌ تفتح أبواب الأمل.
يبقى الأمل الأكبر معلّقًا على النخب الفكرية والشبابية التي ترى في إنهاء دور الميليشيات فرصةً لبناء وطنٍ جامعٍ يتساوى فيه الأفراد أمام القانون، ويتشاركون في صياغة مستقبلٍ يقطع مع ثقافة الاحتراب الأهلي ويؤسّس للتعددية تحت مظلّةٍ وطنيةٍ واحدة. فكلّما ازداد الوعي وانخفضت حدة الصراعات، تهيّأت الظروف لخروج الميليشيات من المشهد لصالح مؤسساتٍ شرعيةٍ وقوانينٍ تنظم حياة المواطنين بلا تمييز.
المنطقة لم تعد تحتمل ترف تأجيل الحلول الجذرية، ولا بدّ من استثمار كلّ فرصةٍ تتاح اليوم لمنع انهياراتٍ أعمق في المستقبل. هكذا فقط يمكن للدول الثلاث أن تستعيد زمام أمورها وتنطلق في مسارٍ وطنيٍّ جامعٍ يضمن السلم والأمان، بعيدًا عن حروب الوكالة وانقسامات الماضي التي أثقلت كاهل شعوبها لعقود طويلة.