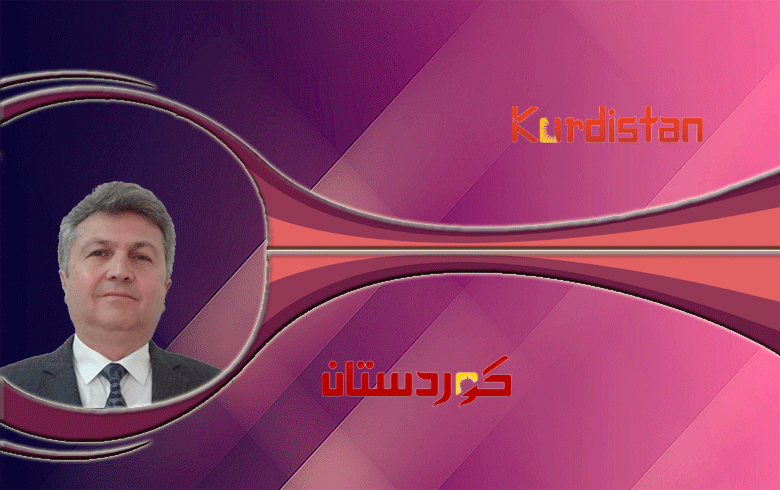القِراءة بين الماضي والحاضر
محمد رجب رشيد
لم يكن عبثاً بِدْأ تنزيل الوحي بكلمة (اقرأ)، بل كان دلالة على أهمية القراءة في حياة الإنسان الفرد لمعرفة الله سبحانه وتعالى ومخلوقاته، ومعرفة نفسه والواقع الذي يعيشه، وتعبيراً واضحاً عن سطوة الكلمة على الناس بغض النظر عن صدقِها أو كذِبها، قسوتها أو مرونتها.
كتب الراهب الألماني مارتن لوثر عام ١٥٢٢م بعد انتشار كتاباته والإقبال عليها في معظم أنحاء أوربّا قائلاً: (أنا لم أفعل شيئاً، الكلمة هي التي فعلت كلّ شيء). كان مُحِقّاً في ذلك، فالمطبعة هي التي أوصلتْ كلمته إلى الناس.
قبل اختراع الأبجدية كان التواصل بين الناس ونقل الأخبار والمعلومات يتِمُّ شفهياً بالتحدُّث والاستماع، بعد اختراع الأبجدية لم يكن كما قبله، فقد بدأ عصر التدوين عن طريق الكتابة التي بِدورها استوجبت القراءة. لقد شكَّلتا معاً ثنائية متكاملة لا غِنى عنها، ماذا كنا سنقرأ لولا الكِتابة؟ وما فائدة الكِتابة إن لم تُقرأ، مَثلهما كمَثل البيضة والدجاجة، ولكن دون البحث عن أسبقية إحداهما من الأخرى.
ومن الجدير بالذكر أنّ القراءة غير مُختصرة على فك حروف الكلمات والنُطق بها، بل هناك أنواع أخرى من القراءة لا تقل أهمية عن قراءة الكتب، كَقراءة العيون والمشاعر، قراءة تعابير الوجه وحركات الجسم، قراءة لحنُ القَول، قراءة النوطة الموسيقية، قراءة الأحفوريات، قراءة المخطوطات القديمة، قراءة رمزيَّة اللوحات الفنية، قراءة المواقف السياسية ونوايا الأعداء، ... إلخ. مِمّا سبق يمكن صياغة تعريف مبسّط للقراءة بأنّها فِعل تواصل مع الماضي والحاضر والمستقبل، ورِحلة إلى آفاق الدّلالات والرُؤى والمعرِفة.
في حياة الإنسان الفرد أمور لا يريد فِعلها، وأمور ينبغي فِعلها، وأمور أخرى يحِبُّ فِعلها. لعلّ القراءة من الأمور التي ينبغي عليه فِعلها حتّى وإن لم يحِبُّها. لا عذر لمن يجيد القراءة ولا يقرأ، خاصةّ وأنّها لا تحتاج أي مهارة أو تكلفة مادية، الأمر يتعلَّق فقط بالرغبة وبعض الفضول لجمع المعلومات. أمّا الكِتابة فهي شيء مختلف تماماً، تحتاج إلى الموهبة والخيال والثقافة، كلُّ كتابةٍ لا بدّ أن يترك أثر ما على القارئ سلباً كان أم إيجاباً، مِمّا يُحمِّل الكاتب مسؤولية أخلاقية فيما يكتب تجاه القارئ والمجتمع. بينما القارئ يتحمّل فقط مسؤولية الإعراض عن القراءة أو عدم فهم رسالة الكاتب والغاية حين يقرأ.
لعلّ أجمل ما يمكن للإنسان أن يُهديه لنفسه هو الإدمان على القراءة منذ الصِغر أو المثابرة على أقلَّ تقدير، فوائدها أكثر من أن تُحصى، كلُّ قراءة فيها من المُتعة ما يجعل القارئ يتنفس المعرِفة كما يتنفس الهواء، ويتسلَّح بأفكار جديدة تساهم في زيادة وعيه وإتساع مدارِكه، هذا فضلاً عن كون القراءة إحدى أهم وسائل تحصيل المعلومات وتحويلها إلى معرفة، والتعمُّق في الموضوعات المُحبّبة إليه إذا أراد.
بالطبع قِلّة من القُرّاء يفعل ذلك، بينما الأكثرية تكتفي بالمُتعة وجمع المعلومات، ولا بأس في ذلك. رُبِّ سائل هنا: ماذا يجب أنْ نقرأ؟ من الأفضل قراءة كل ما يقع تحت ناظِرِينا، وكل ما يقع بين أيدينا من المنشورات والصُحُف والمجلّات والكتب مع الأخذ بعين الاعتبار أنْ تكون الأولوية لِما يخصُّنا، ويخصُّ أعداءنا من باب أعرف عدوك، ثمّ ما يخصُّ العالم.
من الملاحظ أنّ أغلبية الدول الإسلامية تقبع في مؤخرة جداول المؤشِّرات الصادِرة عن الجِهات الدولية، وخاصة مؤشر عدد الكُتب المقروءة سنوياً لكل فرد. بالطبع الأسباب كثيرة، ولسنا بصددِها الآن، ولكن من أهمُّها العزوف عن القراءة. نعم! أمّة (إقرأ) لا تقرأ! وإذا قرأتْ تقرأ ما يضُر ولا ينفع من المرويّات (الأحاديث) المشكوكة في صحتها، والتي ما أنزل الله بها من سلطان، بينما كتاب الله (المصحف الشريف) تُقرأ لأجل القراءة فقط دون تدبُّر أو العمل بها. أمّا تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات فإنّهم يكتفون بقراءة المناهج المقرّرة لتحصيل علامة النجاح، ثمّ يمزِّقون كتبهم ودفاترهم بعد نهاية الامتحان.
لا شكّ أنّ تاريخ الإنسانية حافِل بالاختراعات والاكتشافات، ثلاثة منها ساهمت في نشر العلم والمعرفة على أوسع نِطاق، ونقل الإنسان من حال إلى أفضل، وهي بالتسلسل الأبجدية، المطبعة، الانترنت وبالتالي وسائل التواصل الاجتماعي. مع الأبجدية بدأ عصر التدوين كما أشرنا سابقاً، ومع المطبعة انتشر الكِتاب والترجمات بمختلف اللغات، ولم يَعُدْ العلم مقتصراً على طلاب المدارس والمعاهد والجامعات. لم يُعرف أي جانب سلبي للاختراعين السابقين. أمّا وسائل التواصل الاجتماعي التي ظهرت مؤخراً فقد دخلتْ حياتنا دون استئذان، وجعلت العالم بِحق قرية صغيرة، أحدثت تطوّرات إيجابية في طريقة تفكيرنا ونمط عيشنا، حيث أصبح أي معلومة أو كِتاب مُتاحاً للجميع أينما كان، لا تستغرق عملية الحصول عليه سِوى دقائق معدودة، ليس هذا فحسب بل أصبح بإمكان الأمّيين الذين لا يجيدون القراءة والمكفوفين الاستماع إلى الكُتب المسموعة كما يستمعون إلى الأغاني. لعلّ الكثير مُنّا يسأل الآن: ماذا سيأتي بعد الانترنت؟ إذا كانت مقدرة العقل البشري على الإبداع لا حدود لها فمن المؤكَّد أنّ الانترنت لن يكون النهاية والأفضل لا بدّ أنّه قادم. لكن بموازة ذلك نمتْ سُلطة تكاد تكون فوق جميع السُلطات، لا سبيل إلى إنكارها أو إبطالها، إنّها سُلطة النشر في وسائل التواصل الاجتماعي والتي قد تَدفن العدالة وتخفي الحقيقة عندما تغدو هي أساس أحكام الإدانة والبراءة. ثَمّة نمط جديد من الاستبداد يُعكِّر صفوَ حياتنا اليومية، إنّه استبداد فوضى الكِتابة والصُراخ والشعوبية، يتغذّى عليه الاستبدادان -السياسي والديني- اللذان يكاد يكون اتحادهما ميّزة حصرية خاصّة بمنطقة الشرق الأوسط، المنطقة الموسومة بالعيش دون أمل أو أفق.
قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي كانت للنصّ المكتوب سطوة، وكان للنشر في صحيفة أو مجلة سِحرٌ، فيما يزخر اليوم بكتابات ومنشورات لا حصر لها، غالبيتها خالية من الأفكار، وكأنّنا في سوقٍ يصرخ فيه الجميع لبيع بضاعته، لكن قِلّة من تشتري. فاليوم كل شخص هو كاتب بطريقة أو أخرى، يكتب لتفريغ شُحنتِه دون الإهتمام بالجودة والصِدق، بمعنى ليس كل كتابةٍ إبداعاً. كَثرة الكُتّاب توازيها قلّة القُرّاء، الإبداع دائماً يقترِن بالقلِّة، بينما الرّداءة تقترِن بالكِثرة. أغلبية الناس كانت تشاهد سقوط التفاحة من الشجرة، ولكن لم يتساءل أحد لماذا اتجهت التفاحة إلى الأسفل ولم تصعُد إلى الأعلى، وحده نيوتن شغل تفكيره بسقوطها، فأبدع واكتشف الجاذبية الأرضية.