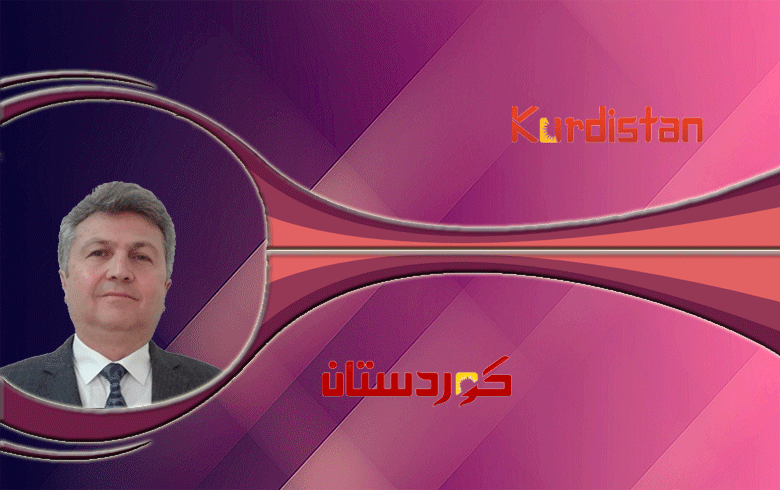الثوابت والمتغيرات
محمد رجب رشيد
لعلَّ تغيير العقل الجمعي للمجتمعات من أصعب المسائل التي واجهت علماء الاجتماع منذ القِدم، فالإنسان بطبعه يتمسّك بتراثه وبما اعتاد عليه، يرفض التخلّي عنه بسهولة وقبول الجديد المختلف. وبما أنّ جوهر جميع الرسالات السماوية -بالإضافة إلى الإيمان بالله- هو النقلة النوعية للمجتمعات من حال إلى آخر أفضل عن طريق التجديد والتغيير، فقد واجهت مقاومة عنيفة في بداياتها. لا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لثورات الشعوب حيث جُوبِهتْ بثورات مُضادّة، ولم تُؤكل ثمارها إلّا بعد عقود من الزمن.
في العالم الذي نعيشه والكون الذي ننتمي إليه، ثنائية قائمة على علاقة جدلية متناقضة بين حَديها -الثوابت والمتغيّرات- إلّا أنّ ذلك التناقض لا يُقلِّل من أهميتهما، هذا إن لم يزيدها، وكما يُقال لا يُعرف الشيء إلّا بنقيضه. بالعودة إلى تاريخ الإنسانية نجد القليل من الثوابت والكثير من المتغيّرات، ولا غرابة أن تكون القومية من الثوابت فضلاً عن الحياة والموت، فكما نعلم لا يمكن للإنسان تغيير قوميته لأنّها لم تكن بالأصل من اختياره، بل كانت من إرادة الله سبحانه وتعالى، أمّا الوطن والدين والعقيدة فهي من المتغيّرات التي يمكن للإنسان اختيار ما يشاء منها وتبديلها بأخرى متى شاء. إذاً كيف نميّز بين الثوابت والمتغيّرات؟
الثوابت حقائق -إيمانية أو علمية- مُقدَّسة، لا تقبل المساس بها أو نقاشها أو إبداء الرأي حولها أو الاستفتاء عليها أو تغييرها. لو أجرينا استطلاع رأي حول بعض التساؤلات: هل نحن أُناس أم لا؟ هل نحن كورد أم لا؟ هل نتنفّس الهواء أم لا؟ هل نشرب الماء ونأكل الطعام أم لا؟ لو صوّت الجميع بِلا على مثل تلك الأسئلة لن يكون للتصويت أي معنى، لأنّنا بالتأكيد أُناس كورد، نتنفّس الهواء، نشرب الماء، ونأكل الطعام. تأتي أهميّة الثوابت من نِدرتها وقدسيتها الأبدية التي لا تتغيّر بمرور الزمن، مِمّا تجعلها كالبوصلة التي لا تُخطِئ الاتجاه الصحيح نحو النجاح في الدنيا والنجاة في الآخرة، وأي محاولة لتغييرها أو إلغائها ستبوء بالفشل، وإنْ كُتِبَ لها النجاح ستكون نتائجها كارثية على الطبيعة أو المجتمع.
بعيداً عن القَداسة وخِلافاً للثوابت تتصِف المتغيّرات بالمرونة وإمكانية المناورة بها وقابليتها للنِقاش وإبداء الرأي حولها وتغييرها، بل والاستغناء عنها عند الضرورة، وهنا تكمن أهميتها، فالإنسان مخيّر بين الإيمان والكفر، وبإمكانه اختيار أي حزب للانتماء إليه وأي وطن للعيش فيه، على عكس القومية وتاريخ والميلاد والممات فلا يستطيع إختيارها أو التحكُّم بها كما أشرنا سابقاً.
ولعلّ من أخطر الأمور على الإنسان الفرد والمجتمع الخلط بين الثوابت والمتغيّرات أو وضعهما في سلّة واحدة، بمعنى أنْ نساوي بينهما، أو نتجاهل الثوابت كَقيمة كُبرى، ونُضفي صفة القداسة على المتغيّرات، ثمّ نتعامل معها وكأنها ثوابت. والأخطر من ذلك تغليب المتغيّرات على الثوابت وبالتالي القضاء على أي نزعة إبداعية مُمكِنة لدى الإنسان. إنّ الخروج عن قاعدة الثوابت والمتغيرات يؤدي بالنهاية إلى ضياع البوصلة وحصول ما لا يُحمد عقباه. وهذا ماحصل ويحصل في المجتمع الإسلامي منذ بدايات الدولة الإسلامية وإلى الآن، إذْ تجاهل الفقهاء المصحف الشريف وما ورد فيها من ثوابت صالحة لكل زمان ومكان كالأحكام والعبادات والأخلاق، وجعلوا من الأحاديث المرويّة والمشكوكة في صحتها شريعةً وكأنّها ثوابت مقدّسة، وذلك نزولاً عند رغبة السلطات السياسية الحاكمة حينها، متناسين أنّ الأحاديث حتّى وإن كانت صحيحة فهي ليست من الشريعة بشيء، وإنما كانت تخصُّ فقط الفترة التي رُويّت فيها.
نواميس الكون لا تخلو من الثوابت والمتغيّرات، سرعة الضوء، الجاذبية، المسافة بين المجرّات والنجوم والكواكب، السنة الشمسية، السنة القمرية جميعها من الثوابت، أما المجرّات والنجوم والكواكب نفسها فهي من المتغيّرات كون أعمارها محدودة وإنْ كانت تُقدّر بمليارات السنين. لا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للكُرة الأرضية، نجد فيها بعض الثوابت مثل حجمها، مساحتها، نسبة الماء إلى اليابسة. والعديد من المتغيّرات كالطقس، البيئة، توقيت شروق وغروب الشمس، المساحات الخضراء، الصحاري، عدد السكان، مساحة المدن، ... إلخ.
وماذا عن الفلسفة والسياسة؟ إنّ ما يميز الفلسفة عن العلوم أنّها غير قابلة للتجربة ولا تخضع لقوانين ثابتة ما يجعل الحصول على حقيقة واحدة فيها أمراً مستعصياً، ولذلك نرى في الفلسفة عدة مذاهب أهمها -الوجودية، العبثية، العدمية- تتجادل حسب آراء أتباعها. أمّا في عالم السياسة الذي لا يعرِف سِوى المصالح، فالثابت الوحيد فيه هو التغيير الدائم حيث تكون المصالح، أمّا السلام، الحروب، الصداقات، العداوات، التحالفات، والمواجهات، فهي من المتغيّرات التي تخدم مصالح الشعوب فقط دون الحكام.
يتضِّح مما سبق أنّ وحدة أي دولة من الدول ليست من الثوابت المقدّسة رغم أهميتها، وإنّما هي من المتغيرات، والمعيار الوحيد لِبقائها أو عدِمها هو رأي الشعب لأنّه أدرى بمصلحته، أحياناً تكون مصلحة الشعب مع الوحدة أو الإبقاء عليها وأحياناً أخرى تكون مع الانفصال، والأمثلة على ذلك كثيرة في التاريخ الحديث نذكر منها:
- الاتحاد الأوروبي أرقى شكل من أشكال الاندماج والتعاون بين الشعوب لم يتشكّل بقرار من رؤساء دولها وإنّما باستفتاء الشعب في كل دولة على حِده. بقيت بعض الدول خارجها احتراماً لقرار شعوبها بعدم الانضمام، ومؤخّراً انسحبت انكلترا منه بعد تصويت أغلبية الشعب على الانسحاب.
- شهدت يوغسلافيا حرباً طاحنة في تسعينيات القرن الماضي لم تكن لتنتهي إلّا بتقسيمها الى عدة دول، الانفصال هنا كان حلاً لوقف الإبادة الجماعية لبعض شعوبها.
- فشلت تجربة الوحدة بين مصر وسوريا لأنّها جاءت بِناءً على رغبة بعض القيادات الحاكمة في البلدين دون أخذ رأي الشعب بعين الاعتبار.
- التشيك والسلوفاك كانتا تشكِّلان معاً دولة واحدة، بعد عقود قرَّر شعبا البلدين الانفصال ودياً، ثم التقيا مرة أخرى في الاتحاد الأوروبي ولكن على أسس ومبادئ جديدة.
- أجرت الحكومة الاسكتلندية استفتاء على الانفصال عن المملكة المتحدة وعندما جاءت النتائج ضد الانفصال رضخت الحكومة لقرار الشعب في البقاء ضمن المملكة المتحدة.
بِناءً على ما سبق المجتمع الدولي مُطالب اليوم قبل الغد باحترام إرادة الشعب الكوردي في تقرير مصيره، عسى أن يمحو وصمة العار التي تُقبِّح جبينه منذ قرن من الزمن.