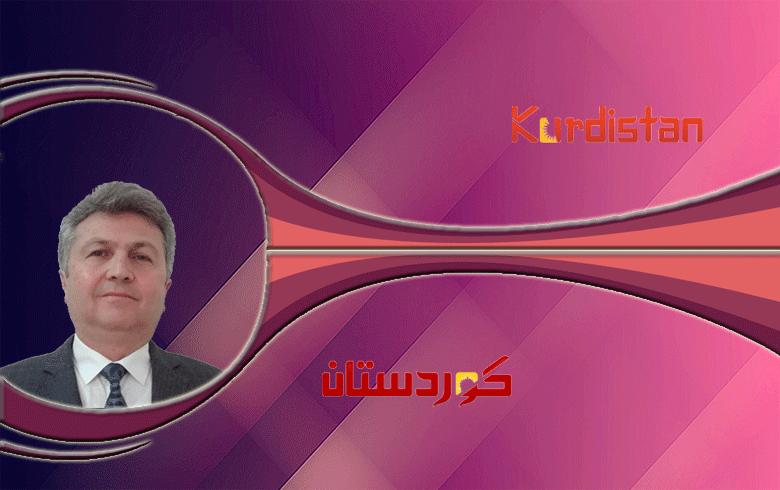خِطاب الكراهية
محمد رجب رشيد
بالعودة إلى التاريخ الحديث نلاحظ أنّ خِطاب الكراهية كان قد ساهم بشكل ملحوظ في تأجيج نار الحُقُد ضد بعض الجماعات والشعوب والأثنيات المغلوبة على أمرها في مختلف أنحاء العالم، وذلك بحشد الرأي العام ضدها تمهيدًا للإبادة الجماعية المنظّمة بِحقِّها، لِتحقيق أهداف عنصرية أو سياسية قذِرة. ولا أدلُّ على ذلك من الإبادة الجماعية للشعب الأرمني من قِبل السلطات العثمانية في العقد الثاني من القرن الماضي، ومحرقة الهلوكوست بحق اليهود من قِبل النازية أثناء الحرب العالمية الثانية، وسلسلة المجازر المرتكبة بحق الشعب الكردي من قِبل الجيش التركي بعد تأسيس الجمهورية التركية سنة ١٩٢٣م، وجرائم الأنفال والقصف الكيماوي على مدينة حلبجة من قِبل الطاغية صدام حسين في نهاية حربها مع إيران. إذا كان خِطاب الكراهية بهذه الخطورة على مستقبل الإنسانية فكيف نتعامل معه؟ ونُكافِحه؟
إذا كان الشيء يُعرف بنقيضه كما يقول المثل الشعبي، فإنّ الكراهية لم تكن لِتُعرف وتكون لها معنى لولا المحبَّة، والإنسان بِطبعه مجبول عليهما معًا منذ خُلِق، وله حرية إختيار أحدهما دون الآخر مع عِلمه المسبق بِعواقب إختياره. إنّ الكراهية بالأصل مشاعِر سلبية تجاه الآخرين أفرادًا كانوا أم جماعات، تتسِم باللا عقلانية والانفعالات الحادِة، وتنطوي على الازدراء والبغضاء. وكما نعلم المشاعر لا تُؤذي الآخرين ولا تضرُّهم بشيء ما لم تتحوّل إلى خِطاب، فالكلِمة التي لا نُلقي لها بالًا قد تتسبّب بتدمير أسرة أو تفكُّكِها، فما بالك بخِطاب قابِل للتطوير إلى سلوك عدواني يفعل فِعله.
يُعتبر خِطاب الكراهية من أكثر المفاهيم المُثيرة للجدل على مستوى العالم، حيث لا يوجد له -حتّى الآن- تعريف دقيق مُتفق عليه من قِبل المجتمع الدولي، وبالتالي يتعّذر المحاسبة عليه، شأنه في ذلك شأن الحرب النفسية الأشدُّ فتكًا من الحرب العسكرية والأقلُّ تكلفةً. رغم ذلك يمكننا القول بأنّ خِطاب الكراهية هو أي دعوة أو ترويج لتشويه صورة شخص أو جماعة أو شعب أو معتنقي دين معيّن، وكراهيتهم واستهداف العوامِل المكوِّنة لهويتهم القومية أو الوطنية أو الدينية، ويتضمن أيضًا العبارات العنصرية الموجّهة للأقليات أو للشعوب الأصيلة. وهنا نجد أنفسنا أمام عِدّة تساؤلات مشروعة: هل خِطاب الكراهية بالخطورة التي تستوجِب حظره؟ أم أنّه يندرج تحت حرية التعبير والرأي؟ وما هو الحد الفاصل بينهما؟
على الرغم من كَون الحرية -بجميع أشكالها- أهم دعامة من دعائم الديموقراطية وحاجة عُليا للإنسان، يعبِّر من خلالها عن ذاته وأفكارِه وخلجات قلبه، فإنّها ليست مطلقة، ولا يجب أنْ تُمارس إلّا مقيّدةً، بِخلاف ذلك ستجتاح العالم فوضى عارِمة لا تُحمد عُقباه. أمّا حرية التعبير والرأي فهي محميّة بموجب القانون الدولي في المادة (١٩) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إلّا أنّ ذلك لم يمنع المجتمع الدولي من وضع بعض القيود عليها، خاصةً فيما يتعلّق بخِطاب الكراهية على أُسُس قومية كانت أم عرقية أم دينية أم أخلاقية.
من المؤكّد أنّ خِطاب الكراهية ليس مجرّد كلمات وجُمل وأوصاف، بل هو صناعة ذات أُسُس وقواعِد لا تُتقِنها إلّا الطُغَم الفاسِدة والنُخب الكاسَدة وأهل الحقد والبغي، يفعل فِعله في هدم المجتمع كالنار في الهشيم. ولطالما أُستخدِم خِطاب الكراهية لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية على حساب الأقليّات الدينية والعرقية والمهاجرين واللاجئين والنازحين وكُل ما يُسمّى بالآخر، وما تهديد تركيا للدول الأوربية بين الحين والآخر بفتح حدودها مع أورُبّا أمام اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها إلّا وسيلة غير أخلاقية لابتزاز تلك الدول.
لعلّ من أهم الآثار السلبية لخِطاب الكراهية فرط العقد الاجتماعي بين مكوِّنات المجتمع الواحد وكأنّه لم يكن، عندئذ أفضل البدائل إنْ وجِدت ستكون بطعم الحنظل، إمّا التقسيم أو دولة فاشِلة بكُل المعايير، وخير مثال على ذلك لبنان، يوغسلافيا السابقة، السودان، ودول ما كانت تسمّى بالربيع العربي. إنّ مكافحة خِطاب الكراهية تقع بالدرجة الأولى على عاتق السُلطات الحاكِمة والمؤسسات التربوية، أمّا المجتمع المدني -إنْ وُجِدْ- فينحصر دوره في الخِطاب المُضاد لخِطاب الكراهية، والذي يتضمّن اللُحمة الوطنية، العيش المشترك، التوعية، التسامح، مِمّا يساعد على الحد من آثاره على أقلّ تقدير، إنْ لم يكن القضاء عليه مُمكِنًا.
من الأهمية بمكان هنا أن تعمل الحكومات على وضع أطُر قانونية لتوسيع الفجوة بين حرية الرأي وخِطاب الكراهية، بحيث يمكن العمل ضمنها لمكافحة خِطاب الكراهية مع عدم المساس بِحرية التعبير والرأي، وذلك بِوضع آلية مراقبة فعّالة، ومساءلة كُل من يدعوا إلى الكراهية أو يحطُّ من قَدَر الآخرين، ومقاضاة المنصّات الإعلامية التي تُنشَر عِبرها.
لقد أدّى التطوُّر التقني في وسائل الإعلام والإتصال ومؤخّرًا وسائل التواصل الاجتماعي إلى جعل العالم قرية صغيرة بِحقّ، تأتي منصّة الفيسبوك في مقدمة تلك الوسائل لطرح الأفكار بِغض النظر عن فائدتها أو ضررها على الأشخاص والجماعات، ونشر خطابات متنوِّعة ومتشابِكة، لعلّ أخطرها خِطاب الكراهية، فضلًا عن النقد الجارِح وغياب الخصوصية الشخصية. إنّ خوارزميات الفيسبوك تُفضِّل المنشورات التي تُثير الجدل، وتحصد المزيد من المشاهدات، وبالتالي المزيد من الأموال من خلال الإعلانات. تشير الدراسات إلى أنّ منشور واحد يتضمّن خِطاب الكراهية من بين كل ألف منشور، رغم التبليغات وإزالة بعض المنشورات المخالفة لقواعد النشر إلّا أنّ المواقع الالكترونية لا تتعاون بالقدر الكافي مع المحاكِم لمقاضاة المستخدمين الذين ينشرون خِطاب الكراهية.
يبقى الخطاب الديني المَوروث -غير مستمِد من كتاب الله- هو الشكل الأخطر من أشكال خِطاب الكراهية، وخاصّةً خِطاب جامعة الأزهر وبالتحديد الشيخ أبو اسحاق الحويني الذي لا يكتفي بالدعوة إلى كُره الآخرين المختلف معهم، بل تكفيرهم وهدر دمائهم واستِباحة أعراضهم ومُمتلكاتهم أيضًا، وحرق الكنائس، الأمر الذي يُهدِّد السِلم الأهلي لكثير من الدول. بِمِثل هذا الخطاب تمّ اغتيال الدكتور فرج فودة، ومحاولة اغتيال الأديب نجيب محفوظ، وتكفير الباحِث نصر حامد أبو زيد، والتفريق بينه وبين زوجته من قبل المحكمة الشرعية.
إنّ الشعب الكُردي كان ومازال ضحية خِطاب الكراهية المُمنهجة الصادرة عن مؤسسات الأنظمة الحاكِمة في الدول التي تضم كوردستان. وإلّا كيف نفسِّر وصف الخُميني الشعب الكُردي بقوم من الجِن كشف الله الغطاء عنهم، ولا يجوز التعامل معهم والتزاوج منهم. وإنكار النُخب التركية وجود شعب كُوردي يعيش على أرض أجداده منذ آلاف السنين، وتزوير الحقائق بِإطلاق تسمية -أتراك الجبال- عليهم. أمّا نظام البعث في العراق -سابقا- فقد وصف جميع المعارضين -كُوردًا وعربًا- بالخونة، لتبرير جرائم الإبادة الجماعية بحقهم، وفي سوريا يُقال عن الشعب الكُردي -خِلافًا للحقيقة- الانفصاليون الوافِدون من تركيا، رغم خُلُّو أهداف جميع الأحزاب الكُردية السورية من إقامة دولة مستقلة.