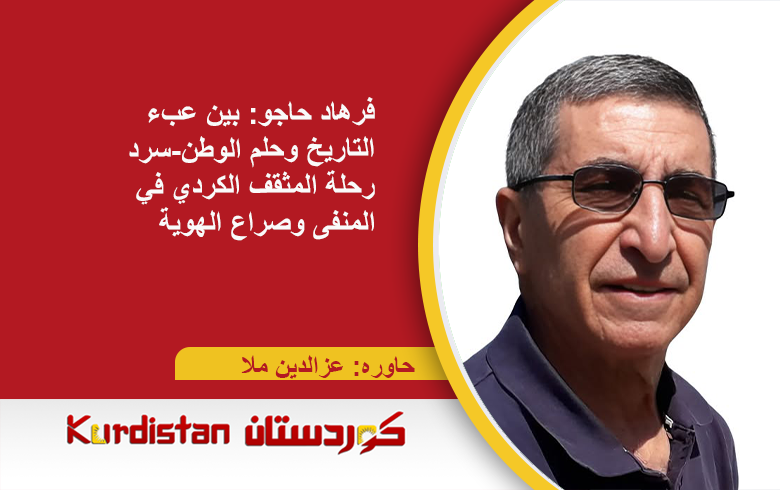فرهاد حاجو: بين عبء التاريخ وحُلم الوطن – سرد رحلة المثقف الكردي في المنفى وصراعات الهوية والسياسة
حاوره: عزالدين ملا
في حياة الأمم والشعوب، هناك شخصيات تحمل على أكتافها هموم تاريخها، تسير في دروب المنفى حاملةً جمرة الوطن لا تنطفئ. الكاتب والسياسي الكوردي السوري فرهاد حاجو هو أحد هؤلاء الذين اختزلوا سيرة شعب بأكمله بين سطور كتاباتهم وخطاباتهم السياسية. عاش أكثر من خمسين عامًا في المهجر متنقلًا بين تشيكيا وألمانيا والسويد، لكن قلبه ظل ينبض بأوجاع كوردستان سوريا، وأحلامها المعلقة بين تشظي الحرب ووعود التغيير. لم تنجح كلُّ محاولاتِ النسيانِ في انتزاعِ جذورِهِ من تربة كوردستان سوريا.
*أريد أن أفتتح هذا الحوار بسؤال: أنتم كنتم ضمن المدعوين إلى مؤتمر وحدة الموقف الكردي في سوريا الذي عقد في مدينة القامشلي، ولكنك ـ وحسب المعلومات المتوفرة لدينا ـ اعتذرت عن قبول الدعوة، لماذا؟
**نعم، هذا صحيح. طبعا، أنا أفتخر بتلقي هذه الدعوة، وكانت الدعوة شفهية من قبل الأخ محمد إسماعيل، سكرتير البارتي الديمقراطي الكوردستاني ـ سوريا. ولكنني اعتذرت لأسباب صحية بحتة، ولأسباب أخرى أطلعت الأخ محمد إسماعيل عليها.
*بما أننا فتحنا الحوار بحدث في الوطن، ما الذي دفعك للمغادرة إلى أوروبا قبل أكثر من خمسين عاما؟
غادرت الوطن في شهر أيلول 1966 إلى أوروبا لأجل الدراسة، لأنني كنت موعودا بالحصول على منحة دراسية من قبل البارتي الديمقراطي الكوردستاني ـ تنظيم أوروبا، وعن طريق اتحاد الطلبة الأكراد في أوروبا. بالنسبة لتجربة المنفى: عندما وصلت إلى أوروبا كنت شابًا عديم الخبرة في مقتبل عمري، وقد أثرت عليّ التجارب التي مررت بها في أوروبا على أكثر من صعيد.
*كيف أثّرت تجربة المنفى على فكرك السياسي والثقافي؟
كأي مغترب كردي آخر، ساهمت بشكل فعال في تفكيك تلك القوالب السياسية والثقافية الجاهزة التي حملتها من الوطن. هذه القوالب لم تكن بتلك القوة التي من شأنها أن تصمد أمام المناخ الثقافي الجديد دون أن تتعرض إلى التفكك. كنت أعتبر أي شيوعي في العالم عدواً بالنسبة لي، لكن بعد احتكاكي ببعض الشيوعيين الألمان تغيرت نظرتي للشيوعية. من خلال اطلاعي على كيفية تفكير الشيوعي الألماني ونظرته العميقة للماركسية، اكتشفت ذلك البون الشاسع بين تفكير الشيوعي في الوطن ونظرته للأمور، وبين الشيوعي الألماني المطلع بعمق على تاريخ التطورات الاجتماعية التي أدت إلى ظهور الفكر الماركسي، ابتداءً من كانط وانتهاءً بماركس. خلال وجودي في أوروبا، كنت أجري دائمًا مقارنات بين طريقة التفكير عندهم وعندنا. خلال تلك المقارنات توصلت إلى أن الأوروبيين يعتمدون في التطور الفكري لديهم على تاريخ وتجارب غنية متأصلة في مجتمعاتهم، أما شعوب الشرق فتُعتمد على نسخ واستيراد ما يتوصل إليه الأوروبيون من نتائج دون النظر إلى تلائم تلك الأفكار مع التطور التاريخي لمجتمعاتنا. وهذا النسخ يشمل كل ما لدينا، بدءًا من النسكافية وصولًا إلى الماركسية.
*هل تعتبر نفسك جزءا من جيل المثقفين الكرد المهاجرين الذين يحملون هموم شعبهم؟
يمكن اختزال هذا التعدد في معيارين استند إليهما الباحثون في تعريف المثقف، وهما معيار الثقافة والوظيفة، وأستطيع القول بأن قسمًا منها لا تنطبق علي. حاولت دائمًا عبر فعالياتي أن أكون جزءًا من جيل المثقفين الكرد المهاجرين. مباشرةً بعد وصولي إلى أوروبا في خريف عام 1966، أصبحت عضوا في تنظيم أوروبا للبارتي الديمقراطي الكوردستاني الذي كان يمثل جميع الأحزاب الديمقراطية الكوردستانية لكافة أجزاء كوردستان. في نفس التاريخ أصبحت عضوا في اتحاد الطلبة الكرد في أوروبا. وربما الأحداث التي تلاحقت بعد انشقاق جلال الطالباني ورفاقه عن صفوف ثورة أيلول عام 1966، العام الذي وصلت فيه إلى أوروبا، كان لها التأثير الكبير على نشاطي الثقافي والسياسي في المراحل اللاحقة، خاصة بعد انتكاسة الثورة عام 1975. نعم، أستطيع أن أقول بأني كنت وما زلت أعتبر نفسي ـ ضمن هذا التوصيف ـ جزءًا من جيل المثقفين الكرد المهاجرين الذين يحملون على أكتافهم هموم شعبهم.
*ما هو أكثر شيء آلمك وما زال يؤلمك بسبب ذلك الانشقاق؟
عند انعقاد آخر مؤتمر لاتحاد الطلبة الكرد في أوروبا عام 1975 في مدينة برلين الغربية آنذاك، بحضور شخصيات من كل أجزاء كوردستان، من بينهم الأمير كاميران بدرخان، قام أحد الأكراد السوريين من أنصار جلال الطالباني بإنزال صورة ملا مصطفى البارزاني من على الجدار الواقع خلف منصة إدارة المؤتمر من مكانها. الشيء الذي آلمني هو منظر جلوس الأمير كاميران بدرخان وحيدًا في قاعة المؤتمر، ومحاولتي إخراجه من ذلك الصمت الحزين، حيث خانته دموعه ـ وهو المعروف ببأسه وشجاعته. قال لي وهو يحدق بالجدار الفارغ من صورة الزعيم الخالد ملا مصطفى البارزاني، ودموعه تنزل بهدوء: "ذهب نضالنا أدراج الرياح، لن نصل لعتبات الحرية، وإذا ما وصلنا سنكون متأخرين جدًا." الذي آلمني أكثر أن تلك الحادثة كانت بمثابة إعلان عن تلك الانشقاقات الدامية في صفوف الشعب الكردي على مدى حقب طويلة في أجزاءه الأربعة.
*كيف توازن بين كونك كاتبًا وسياسيًا؟ وهل ترى أن الأدب يمكن أن يكون أداة تغيير سياسي؟
من الصعب أن أعتبر نفسي كاتبا، فليس كل من كتب بعض المقالات ونشر بعض القصائد يعتبر كاتبًا. لقد نشرت بعض المقالات والقصائد بالعربية والكردية وبالألمانية ـ على نطاق محدود ـ لكنني لا أعتبر نفسي كاتبًا. بالنسبة للأدب، يمكن أن يكون أداة قوية للتغيير السياسي، لأنه عبر القصص والروايات والشعر والمسرحيات، يمكنه أن يؤثر في الرأي العام ويثير النقاش حول القضايا السياسية والاجتماعية. كما يمكنه أن يلعب دورًا في تشكيل الوعي السياسي وتعبئة الجماهير، فقط بشرط ألا يتحول الأدب إلى مجرد أداة للسلطة أو إلى بوق لطرف في الصراعات السياسية ممن يتوقون إلى توظيف الأدب في خدمة أغراضهم الشخصية البحتة، وبشكل يتحول فيه الأديب إلى متسول على أبواب أصحاب القرار وإلى أداة تعرقل عجلة التغيير.
*كيف تُقيّم وضع الهوية الكردية في سوريا؟ هل هناك تهديد لها في ظل التغييرات الديموغرافية؟
يجب أن نعرف الظروف التي تمر بها هذه الهوية والأخطار المحيطة بها. لا يمكن فصلها عما يجري في الأجزاء الأخرى، أي طارئ سلبي أو إيجابي يطرأ عليها في أي جزء من كوردستان لا بد أن يكون له تأثير على الكرد في سوريا، بالرغم من التفاوت في خصوصيات كل جزء بالنسبة لكوردستان روجآفا. فالتهديد الأكبر للهوية الكردية اليوم هو هذا التداخل المعقد للجغرافيا وللتوزيع السكاني للمكونات المختلفة فيها. وكلنا نعرف أن هذا الوضع هو نتيجة الإرهاصات التي تعرضت لها المنطقة بشكل عام، وكوردستان روجآفا بشكل خاص، بداية باتفاقية سايكس ـ بيكو، ومرورًا بالتغيير الديموغرافي خلال أكثر من نصف قرن على يد البعث، وانتهاءً بالهجرة الجماعية التي تعرضت لها روجآفا خلال السنين الأربعة عشر الأخيرة تحت مظلة الثورة السورية وفي ظل الإدارة الذاتية.
هناك تهديد للثقافة الكردية، والتهديد سيبقى وسيدوم طالما الأسباب التي أدت إلى هذا التهديد موجودة. خلال نصف قرن من حكم البعث، كنا نستطيع أن نتمتع برفاهية إيجاد التبريرات لعدم تحركنا بشكل فعال، وإسناد سلبياتنا إلى أسباب موضوعية خارجة عن إرادتنا الذاتية. مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، أتتنا فرصة ذهبية كنا نستطيع فيها استغلال ظروف بشار الأسد للحصول على مكتسبات عالية نسبيًا لم نستطع الحصول عليها منذ تأسيس سوريا، لكن تم إقحام الوطن والشعب في دوامات من التخبط نتيجة صراعات حزبية والركض وراء شعارات أممية بعيدة كل البعد عن الوقائع على الأرض، وما زالت هذه الصراعات مستمرة. فهل هناك من يستطيع أن ينكر بأن الإدارة الذاتية هي السبب في استمرار احتلال أراضينا من قبل مستوطنين عرب سيتحولون في المستقبل إلى أخطر عامل في إنجاح التغيير الديموغرافي الذي يحيط بالشعب الكردي من كل صوب؟ فهؤلاء المستوطنون من عرب الغمر سيشكلون في المستقبل أكبر تهديد أمام مطالبتنا بالتمتع بأي شكل من أشكال الإدارة الذاتية لمناطقنا والتي ناضلنا من أجلها على مدى سنين طويلة. إن دور المثقفين والكتاب الكرد يكمن في الدرجة الأولى في لفت النظر إلى تلك الأخطار التي تحيط بنا، واستنباط الحلول، والتمهيد لوضع الخطط الكفيلة بمعالجة أي حالة طارئة في المستقبل.
*كيف تقيّم دور الكرد السوريين في بلدان الاغتراب بدعم قضيتهم؟ هل استطاعوا تشكيل لوبي ضاغط؟
يجب ألا ننسى بأن الكرد المغتربين ليسوا سوى مرآة معاكسة لما يجري في وطنهم، فهم موزعون سياسيًا وحتى اجتماعيًا بين تكتلات تعكس حالة التشرذم في بلدانهم الأم. ربما التنوع في الانتماءات السياسية ـ الحزبية في بلدان المهجر لها دوافعها التي تختلف عنها في البلد الأم، ولكن نتائجها الكارثية هي أكبر منها في بلد الأم.
فلو نظرنا بدقة إلى الأمور، فسنكتشف تلك العلاقة الوطيدة بين ما يجري على أرض الوطن وبين ما يجري في المهجر. سنرى ظاهرتين بدأت ملامحها تظهر للعيان منذ استيلاء جهات كردية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني على مقاليد الأمور في روجآفا بشكلها العملي منذ 2012. الظاهرة الأولى كيفية توظيف الأموال، الظاهرة الثانية توظيف العلاقات الاجتماعية من خلال عشرنة المجتمع الكردي في روجآفا. لدى الأولى نرى التهافت إلى توظيف المال من قبل شريحة ضيقة من أصحاب الرأسماليين الكرد المقيمين في المهجر ممن يبتغون توظيف ـ تبييض ـ مدخراتهم في البلد الأم بالتعاون والشراكة مع أصحاب القرار هناك، وفي غالب الأحيان على منهج الغاية تبرر الوسيلة: فكثير من هؤلاء يقومون بتوظيف أموالهم في مجال الصرافة والتحويلات المالية من جهة، ومن جهة أخرى هناك من يمنحون القروض – الربا – للطبقة المتوسطة في الوطن مقابل فوائد فاحشة. في الظاهرة الثانية نرى التشجيع المستمر لعشرنة المجتمع الكردي في روجآفا ودفعه إلى التقوقع في تكوينات عشائرية عفا عليها الزمن، وبالتعاون ـ مع الأسف ـ مع شريحة من الأكاديميين والمثقفين الكرد في المهجر. وإلا ما هو التبرير الذي يدفع طبيبًا جراحًا كرديًا يعيش في المهجر منذ عقود إلى تنصيب أحد أفراد عائلته رئيسًا لعشيرة ويضعه في خدمة الإدارة الذاتية لروجآفا؟
هذا لا ينطبق على كل المهاجرين الكرد من روجآفا. هناك أناس مرتبطون بوطنهم من خلال توظيف مدخراتهم في مجال شراء الأملاك والعقارات والتعهدات والبناء.
بخصوص ظاهرة الانتماءات الحزبية، هناك أحزاب توظف كل طاقاتها في عملية صراع أيديولوجي لا تأتي بالنفع لأهلنا في المهجر، لأنه يؤدي إلى تشويه صورة الكردي لدى السلطات، ويؤثر بشكل سلبي على حياتهم. ومثال على ذلك حزب العمال الكردستاني ـ PKK ـ الذي حول مراكز تجمعات الكرد السوريين إلى خرائط للتقسيمات السياسية، وزرع فيها تيارات متصارعة فقط لخدمة إيديولوجيتها.
ورغم هذا، فإن الكرد السوريين المغتربين يعملون ما بوسعهم لأجل دعم قضيتهم أمام الرأي العالمي من خلال جمعياتهم المنتشرة في جميع بلدان العالم، والتي تقوم بالنشاطات ـ سياسية كانت أم ثقافية ـ ويقدمون المساعدات ـ بشكل فردي أو جماعي ـ لذويهم في الوطن. ولكننا حتى الآن لم ننجح، ومع الأسف، في تشكيل لوبي ضاغط خاص بنا للأسباب الآنفة الذكر والمتمثلة في الصراعات السياسية والفكرية.
*كيف تقرأ تجربة الكورد السوريين تحت حكم البعث مثل إحصاء 1962 ومنع اللغة الكوردية؟ وهل يمكن اعتبار ما حدث "إبادة ثقافية"؟
ما حصل للشعب الكوردي بعد إحصاء عام 1962 كانت إبادة عرقية صامتة وجافة، وليست فقط إبادة ثقافية. الإبادة الثقافية تحدث في الحقل الثقافي فقط، لكن ما حدث جراء الإحصاء الجائر بعد أن رفع الملازم محمد طلب هلال مذكرة إلى البرلمان السوري طالباً بناء مستوطنات عربية بين شمال كوردستان وجنوبها وبين أجزاء من كوردستان روجآفا، أثر على الحياة الاجتماعية والسياسية، ناهيك عن الحياة الثقافية. وقراءتي كانت وما زالت هي نفس القراءة الموشومة على روحي أثناء مداهمة القوات الأمنية السورية لمنزلنا في خريف عام 1966 وتطويقها بعشرات الجنود بهدف إلقاء القبض على والدي، وصراخهم في وجهه (يا رأس الأفعى). فلن أنسى ما حييت منظر الضابط وهو يفتش بين كتبي المدرسية على أمل إيجاد كتاب سياسي أو ما شابه، وعندما رأى كتابي المدرسي للتربية العسكرية توجه نحوي وسأل: هل تدرس هذا الكتاب لتلتحق بثورة ملا مصطفى البارزاني وتحرر كوردستان؟؟؟
*ما هو دور المثقفين والكتّاب الكورد في الحفاظ على الهوية الكوردية وتعزيزها؟ وهل أنت راضٍ عن هذا الدور؟
عليهم أن يعملوا على توحيد الصفوف وتعزيز الهوية الكوردية عبر الحوار البنّاء والتوعية بتاريخهم، ودعم المشاريع الثقافية والتعليمية التي تُعزز الوحدة وتُبرز قوة الكورد كشعب.
بالنسبة للرضا، فهذه مسألة لها بعد آخر، لأنها متعلقة بحياة الشعوب المظلومة عامة، وشعبنا الكوردي خاصة. علينا أن نحاسب أنفسنا إلى أي مدى عملنا وسنعمل للحفاظ على هويتنا وتميزنا عن الآخرين. مصير المثقفين والكتاب مرتبط بمصير الأرض، ومصير الأرض مرتبط بمدى تمسك الشعب بالنضال من أجل تحررها، وبالتأكيد المثقفين والكتاب الكورد قسم لا يستهان به من هذا الشعب.
*هل يمكن للأدب الكوردي أن يساهم في الحفاظ على الهوية في ظل محاولات التتريك والتعريب والتفريس؟
الأدب بمثابة المرآة الثقافية التي تعكس الهوية للأمم الأخرى، ويحافظ على فعالية الهوية ويحميها من سياسات الاندماج أو الذوبان في المجتمعات الأخرى، خاصة أننا نعيش في زمن العولمة والذكاء الاصطناعي. الكورد يتعرضون كل لحظة لمحاولات قتل الهوية بهدف إلغاءنا كقومية تعيش على أراضيها. الأدب يحفظ التراث الثقافي ويعمق الوعي بالذات القومية وينقل التراث من جيل إلى جيل عبر القصص والروايات، ويحفظ القيم والانتماء إلى الهوية والأرض، وبالمقابل يعزز بناء الجسور للتواصل مع الآخر وإلى التفاهم بين الثقافات المختلفة.
بالرغم من محاولات التتريك والتفريس والتعريب لقتل الهوية الكوردية، كما يقول المثل الكوردي (الضربة التي لا تقتل تقوي)، وقد حارب الشعب الكوردي عبر الثورات أولاً إلى جانب الأدب كل المحاولات التي استهدفت هويتنا.
*كيف تفسّر ندرة الأدب الكوردي السوري المترجم عالمياً مقارنةً بالأدب الكوردي العراقي أو التركي؟
لأنهم أعطوا الاهتمام الأكبر للحقل السياسي وبقي الأدب محاصراً بمحاولات أغلبها فردية، بالرغم من ذلك اتجه الكثيرون منهم إلى الكتابة عن الواقع الكوردي باللغة العربية سواء في حقل الشعر أو الرواية أو القصة. الترجمة بحاجة إلى مؤسسات تتابع الأعمال المستحقة للترجمة، لكن الوضع السياسي المستبد لأكثر من نصف قرن والاهتمام الكامل بالسياسة أثرا على تقدم مسيرة الأدب الكوردي في روجآفا.
*كيف تنظر إلى وضع الأطفال الكورد في سوريا (التجنيد، التعليم، الفقر)؟ وما الحلول المقترحة؟
أبشع ما في الحروب هو وضع الأطفال، حيث يتم استغلالهم ومن أخطرها التجنيد قسراً أو طوعاً، لأن طولهم لا يصل إلى أنصاف بنادقهم التي تعرضهم للعنف ولصدمة نفسية وجسدية تبقى معهم لمدة طويلة وقد تدوم للأبد.
إن تجنيد الأطفال في العالم تعتبر جريمة حرب بحق الإنسانية وهو انتهاك للقانون الدولي والإنساني.
والحل الوحيد هو التوقيع على الاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق الأطفال وتمنع استغلالهم أو إشراكهم في المنازعات المسلحة. لكن، من سيمضي على هذه الاتفاقيات؟ فالإدارة الموجودة في روجآفا، بحكم عدم شرعيتها الدولية، ليست مخولة بالتوقيع على مثل هذه الاتفاقيات، بل حتى ليست من مصلحتها التوقيع عليها.
أما بالنسبة للتعليم والفقر، ففي كل دول العالم يكون المكان الأساسي للأطفال هو المدرسة، إذاً الحل هنا هو بناء مؤسسات تربوية وتعليمية تحمي أطفالنا من الضياع والاحتراق بنيران الحرب.
*كيف تنظر إلى وضع المرأة الكوردية في سوريا؟ هل حققت تقدماً حقيقياً أم لا؟ كيف؟
الكثيرون من المستشرقين كتبوا عن المرأة الكوردية ومنهم الباحث الروسي المعروف فلاديمير مينورسكي (إن الكورد هم أكثر تسامحاً من جميع الشعوب الإسلامية الأخرى المجاورة تجاه المرأة).
لم يحصروا دورها في الإنجاب والأمومة فقط، لأنها شريك في الحياة. اليوم يمر الشعب الكوردي بأزمة ومن الضروري فتح المجال على أوسع أبوابه أمام المرأة لتساهم في النضال من أجل حرية الوطن، فكل الحريات تبقى أسيرة إذا كان الوطن يئن تحت نير الاستبداد، ونجاح المرأة في النضال من أجل تحقيق كافة حقوقها لن يتحقق إلا مع حرية شعبها ووطنها.
عن المشاركة السياسية للمرأة في الحركة الكوردية، لم تتحول مشاركتهن إلى حالة عامة، ما عدا في تجربة حزب العمال الكوردستاني التي استخدم فيها الحزب المرأة كمادة دعائية تسويقية أمام المجتمع الغربي على المستويين الاجتماعي والعسكري، بل بذل هذا الحزب كل الطاقات الموجودة لديه لأجل تحوير مفهوم نضال المرأة في سبيل حقوقها. نعلم جيداً بأن هذا المفهوم هو مفهوم مستورد من الغرب، وهو في أعلى مستوياته يدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة. أما مفهوم حرية المرأة المؤدلج الذي يطرحه حزب العمال الكوردستاني ورئيسه عبد الله أوجلان فهو مفهوم آخر بعيد عن المفهوم التقليدي الذي تأسس عليه نضال الحركات النسوية في العالم. وهو بمثابة الأسر وليس حرية، وهنا الفرق شاسع بين مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة من جهة وبين مفهوم حرية المرأة.
*ما هي أولويات إعادة إعمار المناطق الكوردية في سوريا بعد سنوات من الحرب؟ وما دور المغتربين الكورد في ذلك؟
تحتاج مدننا وقُرانا إلى إعادة بناء جديدة لأنها في حالة مزرية، والناس تعيش في وضع ما تحت خط الفقر، وهذه مسؤولية من بيدهم مقاليد الأمور وربما جزء لا بأس به من هذه المسؤولية يقع أيضاً على القطاع العام. وهنا لا بد من توظيف كل المصادر المتاحة لتوفير الأرضية اللازمة لمستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي والتجارة لخلق فرص العمل للشباب والعاطلين عن العمل. سيتحقق ذلك عبر خلق أجواء آمنة تساعد على جلب رأس المال المادي والبشري من خارج الوطن وفتح مجال عودة اللاجئين، خاصة من القاطنين في المخيمات في باشور كوردستان. سيساعد ذلك ليس فقط على انتعاش الاقتصاد، بل أيضاً على الوقوف في وجه التغييرات الديمغرافية التي تشكل تهديداً للهوية الكوردية. وهذا ينطبق أيضاً على المغتربين، حيث لا بد من وضع الخطط الكفيلة بتشجيع الاستثمار.
*هل هناك مشاريع تنموية محددة تود أن تطرحها أو تدعمها في المناطق الكوردية مثل التعليم، البنية التحتية، الزراعة؟
هذه المشاريع بحاجة إلى مؤسسات وشركات كبيرة. وأنا واثق بأن تلك الجهات لا تقدم أي شيء بدون مقابل. والمقابل هنا يأتي بالدرجة الأولى على شكل حزم من الضمانات التي لا تتحقق إلا من خلال أجواء آمنة، وهي لن تتوفر إلا من خلال الشفافية، والتي بدورها لن تتحقق إلا في أجواء ديمقراطية حقيقية.
*ما هي الرسالة التي تود توجيهها للشباب الكوردي في سوريا اليوم؟
شبابنا ليسوا كما الشباب في الماضي، لأنهم متعلمون ويفهمون الحياة. هم ليسوا بحاجة إلى رسائل تحفيزية بقدر حاجتهم إلى الاحتواء من كل الجوانب ليكونوا أقوياء في كافة مجالات الحياة. كل عام يتخرج العشرات من هؤلاء الشباب من الجامعات لكن مع الأسف يذهبون للعمل في مجالات بعيدة كل البعد عما درسوه في الجامعات.
هم ليسوا كالسابق لنستطيع إقناعهم بالكلمات الفضفاضة، لأنهم يستطيعون الانتقال افتراضياً إلى أي مكان في العالم عبر الإنترنت. فقط أقول، قبل أن تصدقوا ما تسمعونه ضعوا إشارة استفهام على كل كلمة تقال لكم، يجب عليكم تطبيق مبدأ فلسفة الشك المنهجي الذي يستخدم كأداة للوصول إلى الحقيقة عبر التساؤل النقدي والتحقق من الأسس المعرفية. فوجودكم يتحقق عبر تفكيركم (أنا أفكر إذن أنا موجود). يجب علينا أن نساند هؤلاء الشباب عملياً وليس من خلال توجيه الرسائل إليهم. فهؤلاء الشباب هم رسلنا للمستقبل.
*هل يعي الجيل الجديد من الكورد السوريين تاريخهم جيداً؟ وما دور المثقفين في توثيق الذاكرة الجمعية؟
أحذرهم من الوقوع في الفخ القاتل الذي وقعت فيه شعوب المنطقة من العرب، الفرس، والأتراك من تزوير تاريخهم وسلب ونهب تاريخ الآخرين. حتى اليوم عندما يفتش المرء عن أصل أحد هؤلاء يكتشف بأن هناك ابن سينا عربي وفارسي وتركي. الشعب الكوردي هو الضحية الأكبر لهذا التزوير. هناك بعض الكورد السوريين ينتهجون نفس النهج ويحاولون الحصول على نسختهم الكوردية من ابن سينا. محاولة بذل الجهد في سبيل اكتشاف النسخة الكوردية من ابن سينا لها مبرراتها. ما لا يمكن هضمه هو بذل جهود مستميتة من قبل بعض كتاب التاريخ من الكورد السوريين لأجل تزوير تاريخ بعض الشخصيات الكوردية وصبها في قوالب تتلائم مع توجهه السياسي أو الانتماء الاجتماعي.
ما لا يمكن التغاضي عنه هو دور المثقفين الكورد خلال النصف الثاني من القرن الماضي في توثيق تاريخ كوردستان الغربية بالاستناد إلى المصادر الموثوقة. النجاح الأكبر يمكن تسجيله لحساب الكورد السوريين هو قيامهم بتوثيق الذاكرة الجمعية أو التاريخ الشفوي. لكن ما زال مركز الضعف يكمن في عدم تدوين التاريخ الوثائقي وأرشفته بشكل موضوعي بعيداً عن تزوير الحقائق والانجراف إلى الفخ الذي نوهت إليه سابقاً.
تاريخنا مليء بالأحداث العظيمة لكنها لم تكتب كما يجب أن يكتب التاريخ. هناك عشرات الكتب التاريخية التي صدرت مؤخراً لكن معظمها ليس بالمستوى العلمي في كتابة التاريخ، يمكن إدراجها تحت بند المبادرات الفردية الغرض منها في أكثر الأحيان توفير ثمن الاحتياجات اليومية.
لدى الجيل الجديد إمكانيات عبر تطبيقات التكنولوجيا، ولديهم إدراك واسع بكيفية التمييز بين الحقيقة والتزييف.
*ما هي مشاريعك القادمة على المستوى السياسي أو الثقافي؟
كانت لدي بعض المشاريع على المستوى الثقافي - خاصة في مجال السينما بالاعتماد على مجموعة نشطة من الشباب في هذا المجال - لكن تقدمي في العمر وعدم وضوح الوضع السوري عامة والوضع الكوردي خاصة حالا دون تنفيذ هذه المشاريع.
*هل تعتبر نفسك منفيّاً أم مغترباً طوعياً وما هو الفرق بينهما؟
أعتبر نفسي منفيّاً ومغترباً كرهاً وليس طوعاً. خرجت من الوطن بهدف الدراسة وليس اللجوء أو الهجرة، لكن وصول حزب البعث إلى الحكم في سوريا وتطبيق مشروع محمد طلب هلال للحزام العربي دفع بي وبأغلبية آل حاجو للجوء إلى المنافي لأن أحد بنود مذكرة طلب هلال هو قطع رأس الأفعى مشيراً إلى أبناء وأحفاد حاجو.
المصطلحان يحملان في طياتهما نفس المفهوم لأنهما يدلان إلى دائرة واسعة من المعاناة المؤلمة وإحساس مشابه بإحساس بتر القدمين. هناك جدار يفصلك عن الوطن لا تستطيع تسلقه وأنت مبتور القدمين. أنت مهاجر خارج وطنك وتحمل في داخلك وطناً مهاجراً. أنت تجدل كل يوم حبالاً من الأمل في تسلق ذلك الجدار الفاصل، ولكنك تستكشف أن الجدار قد زاد في ارتفاعه. وهكذا تمر السنين وأنت تجدل الحبال وتعرف بأنها لن تفيدك لكنها تكفي لتجديد الأمل. المشكلة الآن لا تكمن في ارتفاع الجدار الفاصل بين المهاجر والوطن، بل هي تكمن في الأحداث التي تؤدي إلى عدم الاستقرار على الطرف الآخر من الجدار.
*هل لديك خطط للعودة الدائمة إلى سوريا؟
كانت وما زالت لدي خطط للعودة الدائمة، لم أنقطع يوماً عن زيارة الوطن حتى أثناء مرضي لم أبتعد عنه، حفظت كل الدروب التي تؤدي إليه عن ظهر قلب، عن طريق دمشق وهولير وكل البوابات التركية بدءاً من نصيبين، الدرباسية، جرابلس وانتهاءً ببوابة إبراهيم الخليل أعبره عن طريق أراضي إقليم كوردستان وأتوجه مباشرة إلى معبر سيمالكا. قبل الثورة كنا على وشك العودة الدائمة ولأجل ذلك بنيت منزلاً جميلاً على مساحة دونمين من الأرض، قريبة من جامعة المأمون - في ذلك الوقت - القريبة من مدينة قامشلو. ليس هذا فقط بل قمت بالتدابير اللازمة لتسجيل إبنتي سارين في تلك الجامعة. هذا كله كان قبل قيام الثورة. لكن الأحداث قضت على مخططي، عندما أردت بيع المنزل رفض أولادي خاصة إبنتي سارين التي رفضت بشدة لأنها معجبة بمدينة قامشلو وما زالت تتشبث بأمل العودة مع إبنتها للوطن.
*إذا طُلب منك كتابة رسالة إلى فرهاد حاجو الشاب قبل 50 عاماً، ماذا ستقول له؟
سأخبره عن شعوري بالحنين إلى عبق الربيع ورائحته التي تفوح من سنابل القمح المتمايلة مع الريح بعد زخة مطر رعدية غزيرة في شهر نيسان. إنها تذكرني بتلك الأيام التي كنت أسير فيها بين حقول القمح وأنا أراجع كتاباً مدرسياً استعداداً للامتحانات. سأبوح له بالكثير من الأحداث التي التقيت بها على مفترقات دروب هذه الحياة، سأخبره عن تلك الأمنيات التي بقيت رهينة أيامي التي تركتها ورائي في مدينة تربسبية وأنا ما زلت في مقتبل العمر، وأجملها نصائح والدتي لي عندما كنت طفلاً بعدم اللعب مع الأطفال من عمري وتوجيهها بقوة للذهاب إلى مضافة والدي كي أجالس من هم أكبر مني سناً وتجربةً لأتعلم منهم سبل الحياة.
سأخبره عن حقل الخضار خلف الثكنة الفرنسية الذي كان لا بد أن أمر به، وأنا في طريقي إلى المضافة قبل غروب الشمس، لأقوم بطقسي اليومي في قطف حبة بندورة ناضجة أقضمها ثم أغسل أصابعي في المياه الضحلة لساقية الري، أمسح بها وجهي. سأخبره عن مواسم الحصاد وأمسيات الصيف وصمت الحقول قبل الهزيع الأخير من الليل. سأذكره بقطرات الندى على سنابل القمح. أخيراً سأخبره عن الناس الذين كنا نحترمهم ونقبل أياديهم ليس لأنهم أغنياء، بل لأنهم أناس جبلت نفوسهم، برغم فقرهم، بالكبرياء وبعزة النفس وبالأخلاق الحميدة.